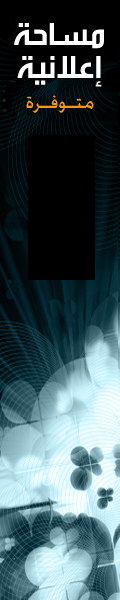[size=16]استضافت مدينة حلب أخيراً فيلم المخرجة السورية هالة العبد الله «أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها»، بمبادرة من بعض أصدقاء السينما في بيت قديم في المدينة العريقة. الفيلم أثار نقاشاًَ هادئاً، ومبشّراً بجمهور مثقّف ومحبّ للسينما، في واحدة من أبرز المدن السورية وأكثرها فقراً بعروض السينما.
لا تخفي هالة العبد الله، في فيلمها التسجيلي الأول، الذي شاركها في إخراجه عمّار البيك، رغبتها في أن تصب كل أحلامها ومشاريعها السينمائية في هذا الفيلم: «أردتُ أن أحقّق أفلامي في سوريا وليس في الغربة. لكن، بعد خمس وعشرين سنة، عندما رأيت عمر الخمسين يقترب، والعودة النهائية إلى البلاد تبتعد، تنبّهتُ إلى أن مشاريع أفلامي تتراكم فوق ظهري، وأن الوقت حان لأتخلّص من هذا الحمل. إن فيلماً واحداً يمكن أن يجمعها، هذا الذي أبدأ اليوم به». لكن، ما يبدو أن الفيلم يريده أولاً هو حكاية نساء ثلاث ينتمين إلى جيل واحد تعرّض للنفي والهجرة أو السجن، وهو يروي تجاربهن. من الواضح طبعاً أن المخرجة العبد الله تنتمي إلى هذا الجيل، فهي الأخرى تعرّضت للسجن والغربة، وما حكايتها مع السينما ومشروعها السينمائي المتأخّر إلا جزء من الحكاية، حكاية هذا الجيل الذي بدأ بطموحات وأحلام هائلة، وانتهى إلى عذابات وانكسارات بحجم تلك الأحلام. بهذا المعنى، يمكن النظر إلى الفيلم كأنه مرثية لجيل، وعنوان الفيلم لا يوارب، كذلك التأكيد على لوحة يرسمها يوسف عبد لكي (زوج المخرجة) في الفيلم، والتي تمثّل قبضة يد مصممّة لكنها مقطوعة.
كان بإمكان الفيلم أن يبقى هنا، مع هؤلاء النساء، وهو معهن قد بدأ مؤثراً بالفعل. وعلى الرغم من أن الكاميرا راحت تسرح طويلاً فوق وجوههن (فاديا لاذقاني، رولا الركبي، راغدة عساف) بصمت، ومع انفعالات عادية ويومية أحياناً، عادية إلى حدّ أن لقطات كثيرة صوّرت أثناء التحضير، أو على الأقل كنّ قد تعاملن مع الكاميرا على هذا الأساس؛ إلا أن المُشاهد كان بإمكانه أن يسرح معهن ومع شرودهن، بحنان ومن دون تطلّب لحكاية أو فاجعة. كان الكلام والانفعال البسيط هما الأكثر تأثيراًً: «أعطيني ميّ، نشّف قلبي»، «تصوّري كيف صرنا». غير أن العبد الله لم ترد أن تقف هنا، بل أرادت أن تقول كل شيء دفعة واحدة. يمكن للمرء أن يلتقط خمسة أفلام على الأقل في فيلمها: واحد عن الشاعرة السورية دعد حداد، وهي إحدى العلامات البارزة لذلك الجيل، وقضت في وقت مبكر، وقد استُلّ عنوان الفيلم من قصيدة لها، مع أنه يصعب فهم استدعاء الشاعر نزيه أبو عفش لنستمع منه إلى تلك العبارة «أنا التي تحمل...» ليعيدها مراراً وتكراراً. أما الفيلم الآخر، فيمكن أن يكون عن التشكيلي السوري البارز الياس زيات، وقصة ترميمه الأيقونات وإعادة بعثها من جديد. هناك بالطبع فيلم عن يوسف عبدلكي، الذي صوّر عمار البيك بعض مشاهده بالفعل، قبل أن يتخلّى عنها لفيلم مشترك مع هالة. هناك أيضاً حكاية هالة، التي يمكن أن ترويها بمفردها: عن تجربتها في صناعة الأفلام مثلاً، وأي عقبات تواجه سينمائية مثلها في بلدها وخارجه. وهناك، أخيراً، حكاية أم يوسف، التي نجت من المجزرة وهي بعدُ طفلة.
لا تُخفى الروابط بين مختلف الحكايات. لكن، بدلاً من أن تأخذ هالة جوهر الفكرة من الأشياء، راحت تسهب وتستسلم لكل حكاية جديدة. كان يُمكن الاكتفاء من زيّات وأيقوناته بعبارة أو صورة واحدة تفسّر البحث في الركام الأسود للزمن فوق اللوحة للوصول إلى الأيقونة؛ ويمكن أن يستعير الفيلم من عبد لكي ما يدعم حكاية هالة، من غير أن تقدّم حكاية يوسف كاملة. أما لعبة انكشاف عملية التصوير، أو ما يُمكن تسميته المسرح داخل المسرح، حيث تكشف المخرجة كيف تلقّن شخصياتها الواقعية التحرّك والتمثيل، كذلك فعلت حين أعادت ما قاله أبو عفش عن دعد حداد من زاوية أخرى بشكل حرفي... لا ندري أي توظيف لها.
ذلك كلّه لا يلغي أن الفيلم مؤثر، وإن شابه شيء من الملل، هو الذي لا يقلّ عن الساعتين إلا قليلاً. ولا شك في أن أجواء العمل ومناخاته مدروسة بعناية، إذ يبدأ الفيلم من عناكب نسجت خيوطها فوق الجسر، وبتتبع حركة سرب من الطيور، وبكاميرا مهتزة تذرع الأرض ركضاً أحياناً. مناخات موحشة عموماً، يزيد منها اختيار الأبيض والأسود لغة للفيلم، وهذا الاختيار جاء تالياً، باعتبار الفيلم صُوِّر على مراحل. أراد الإخراج أن يوحّد أسلوبية الفيلم عبر الأسود والأبيض، لكن هالة العبد الله ترى في ذلك هدية من هدايا مصادفات السينما.
راشد عيسى - الجمل
[/size]