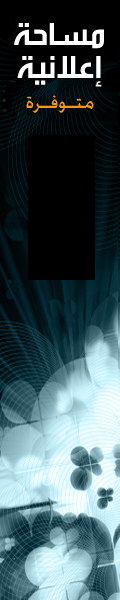مجدي يوسف
محاولة مشروعة
الآن أتناول في عجالة مناقشتى الناقدة لكتاب مارتن برنال: "أثينا السوداء" (الذي كثيرا ما أشار إليه وأشاد به الراحل إدوارد سعيد).
ينقد برنال الفكرة الشائعة التي ترى أن هنالك حضارة غربية، وأنها تعلو على سائر الحضارات والثقافات، بينما تستمد مجدها من حضارتي الإغريق والرومان. وهو يقدم الدلائل والحجج الفيلولوجية على أن كلا من الحضارتين الهيلينية والرومانية يدين بالفضل إلى حد بعيد إلى الإبداعات الثقافية لحضارات الشرق الأوسط، وبخاصة لحضارتى مصر القديمة وما بين النهرين.
وقد حاول برنال أن يجمع الأدلة على أن اليونان كانت مستعمرة للمصرين القدماء قبل أن تطأ القبائل الهيلينية برها الأصلي وجزرها. ولما كان المصريون يتميزون بالبشرة الداكنة، فقد حرص برنال على أن يكون عنوان كتابه "أثينا السوداء" ليأكد مساهمة المصريين الثقافية التي استمرت أصداؤها طوال الحقبة الهيلينية.
وقد أثار كتاب برنال الكثير من ردود الأفعال في الغرب. كما أن كثيرا من الباحثين الذين تعود أصولهم إلى بلاد غير غربية، من أمثال سعيد، قد عبروا عن ترحيبهم بهذا الكتاب.
أما نقدي لمنهج برنال فمعرفي فلسفي. ذلك أن مدخله التاريخى التعاقبي يؤكد على الثقافة المرسلة وإبداعاتها، بينما يغمط من قيمة الثقافة المستقبلة (المتلقية)، التي تمثل في هذه الحالة منتجي الثقافة الإبداعية، سواء في الحقبة السابقة على الحقبة الهيلينية أو أثنائها، في تفاعلهم بطريقتهم الخاصة مع القيم الوافدة عليهم من الثقافة المصرية القديمة وفقا لسياقاتهم الثقافية الاجتماعية المختلفة (عن تلك التي أنتجت الإبداعات الوافدة في إطارها).
من هنا فـ برنال لم يتجاوز المنهج التقليدي للمركزية الأوربية من الناحية الإبستمولوجية (الفلسفية المعرفية)، وهو المنهج الذي تمثل، على سبيل المثال، في توجه المدرسة الفرنسية للأدب المقارن في مرحلة الخمسينيات. فهو يبدأ دائما بالإبداعات الأدبية القومية ثم يسعى لأن يتتبع استقبالها ومدى نجاحها في الآداب والثقافات الأجنبية. أما الفارق الوحيد بين هذا التوجه الفرنسي التقليدي في الأدب المقارن، وذاك الذي ينهجه برنال، فهو أن الأخير يعكس اتجاه الثقافة المفترض فيها أن تكون سائدة، بأن تصبح في هذه الحالة إسهامات حضارتي الشرق الأوسط هي الأصل والمنبع، بينما يفترض في الحضارات الغربية أن تكون - بدورها - في الطرف المتلقي السالب.
فبينما يعرض برنال لعملية التأثر، أو بالأحرى التبادل الثقافي، إذ به يجرد ذلك عن التغيرات الهامة التي لعبت دورا رئيسا في عملية تلقى الإسهامات الثقافية المصرية القديمة، وتلك الوافدة من حضارة ما بين النهرين (والتي انتقلت عبر اليونان إلى مختلف الأقطار الأوربية).
في المقابل نجد أن المنهج الذي يحترم الاختلاف الثقافي الاجتماعي الموضوعي، ليس فقط بين الأمم بعضها والبعض الآخر، وإنما بالمثل بين الثقافات الاجتماعية المتباينة في البلد الواحد، يمكن أن يؤدى إلى بديل حقيقي لذاك النهج أحادي التوجه، في تعاقبيته السلطوية ومركزيته العرقية التي يكرسها برنال عن غير وعي منه، وذلك بالرغم من أن عمله هذا يستهدف (ذاتيا) تعرية الأوهام الصوفية المتمركزة حول الذات (الغربية) والمتمثلة في مفهوم وتصور الإرث الثقافي الأوربي المشترك.
وفضلا عن ذلك فإن برنال قد ترك سؤالا آخر بلا إجابة: إذا كانت ثقافات الشرق الأوسط تشكل المنابع الأصلية للحضارات الغربية، فما هي منابع حضارتي مصر القديمة، وما بين النهرين بكل ما تميزتا به من إبداعات؟
أترجع منابعهما مباشرة إلى الطبيعة الأولية؟! إن مثل هذا الافتراض ليس من اختراعنا، وإنما – كما رأينا من قبل – هو من "اجتهاد" زكي الأرسوزى، مفكر البعث السوري الراحل (الذى تتلمذ في فرنسا على برجسون) في كتاباته عن مصدر اللغة العربية.
فبإرجاع الإبداعات الثقافية إلى الطبيعة الأولية ، إنما نسلب أنفسنا فرصة فهمها واستيعابها باعتبارها نتيجة عمليات تفاعل ثقافى ترجع جذورها إلى اختلاف السياقات الاجتماعية الثقافية.
أود هنا أن أشير إلى أن برنال لم يكن وحيدا في نهجه. ففي الوقت نفسه الذي صدر فيه كتابه "أثينا السوداء" - أي في النصف الثاني من الثمانينات – أنتج فيلما عنوانه "أطلانطيون" للمخرج الآيرلندي بوب كوين القاطن في محافظة جولواي: في هذا الفيلم يحاول كوين أن يبرهن على أن أصول الحضارة الآيرلندية لا ترجع إلى "كلت" الشمال الأوربي، وإنما إلى مصر القديمة وحضارة ما بين النهرين. وهو يتتبع في فيلمه هذا الخط الثقافي للمسيحية من كايرو (القاهرة) حتى كيريرو، حيث يقيم ويعمل في إحدى ضواحى جولواي المطلة على المحيط الأطلنطي.
وقد تمنطق هو نفسه في هذا الفيلم بقلنسوة كالتي يضعها الرهبان المصريون الأقباط على رؤوسهم ٍمشيرا بذلك إلى أصول انتقال المسيحية إلى آيرلنده عن طريق القديس باتريك. وقد حرر كوين كتابا بالمثل أسماه "أطلانطيون – تراثنا الثقافي الشرق أوسطي".
إلا أننا إذا ما وجدنا العذر لمثل هذا العمل الفني التخييلي المناهض للمركزية الأوربية، بنياته النبيلة التي عبر المخرج من خلالها عن رغبته في مزج وتماهي الشعب الآيرلندى بغيره من الشعوب المهمشة بمعايير المركزية الغربية المهينمة حاليا، فهو لا يمكن أن نحاسبه على أنه عمل علمي ينتظر منه أن يدرس (أو يوعظ به) في الجامعات الغربية، كمؤلف آورباخ المعنون "المحاكاة"، أو كتب إرنست روبرت كورتيوس (ما عدا بالطبع كتابه "الروح الألمانية في خطر"!)، ومع ذلك: أليس من باب المفارقة أن كلا من آورباخ وكورتيوس لم يتجاوزا كوين في شيء مما "حققاه": فقد اخترعا مصدرا، أو نقطة مرجعية متخيلة، أو "مهدا" خياليا ومفعلا منشطا لثقافات اجتماعية راهنة يصفانها بأنها أوربية (بالمفرد) على الرغم مما بينها من تمايزات واختلافات لا يمكن أن تغيب عن أية درس مدقق لها. ومع ذلك كله فما زالت أعمال هذين المؤلفين تحظى في الغرب بكل التقدير والإعجاب باعتبارها "إسهامات علمية وعقلانية أساسية"!
ولعل مما دعم الإقبال على أعمال هذين المؤلفين أنها سعت لنقد النزعة الريفية للقومية النازية التي حاولت أن "تجرمن" سائر الشعوب الأوربية خلال فترة حكمها (1939-1945). إلا أن حجة كل من آورباخ وكورتيوس لا تعدو أن تشكل ريفية جديدة تقوم على أساس الفصل بين ما يتصورانه إرثا يشترك فيه الغربيون وحدهم (وهو يعلو - بالطبع - عن كل ما عداه من تراثات للبشرية) حيث يعود إلى حضارتي الإغريق والرومان، بينما لا يشارك الأوربيين في هذه الأصول الصفوية أي من أصحاب الثقافات (واللغات) غير الغربية.
كما أننا نجد أن كورتيوس ليس بعيدا تماما عن النزعة الفاشية التصوفية التي حرصت بطريقتها الخاصة على إعادة إحياء الإرث الروماني العتيق. فعلى النهج نفسه حرص "كورتيوس" على أن يرد ما اعتقد أن فيه وحدة تضم الآداب الأوربية إلى مستودع أساطير العصور الوسطى اللاتينية، حيث يلاحظ هنا مدى تقاربه مع النظريات الرومانسية التي تأثر بها كل من الفاشيين الإيطاليين والشاعر إزرا باوند.
ولعل تلك النزعة المتحيزة لنظرية كورتيوس تبدو واضحة للعيان حين نعلم بمدى الصداقة التي كانت تجمعه بـ ت. إس. إليوت الذي هرول بدوره لزيارة صديقه كورتيوس في بون بمجرد فتح الحدود الألمانية في عام 1947 (كما سبق أن أشرنا فى مطلع هذه الدراسة!).
أما بشأن برنال فمن الطبيعي أني آخذه على محمل الجد أكثر مما أفعل مع فيلم بوب كوين. فلا شك أن محاولة برنال لتحدي المركزية الأوربية مشروعة تستحق منا كل احتفاء. ولكن السؤال المطروح هو: هل ستنجح حقا في مسعاها؟!
وإذا كنتُ قد أبديت بعض النقد والاعتراض، ليس فقط بالنسبة لـ برنال، وإنما بالمثل بالنسبة لكل من سعيد وإتيامبل، فإنه لا يجوز أن يقلل ذلك من أهمية إسهاماتهم، أو أن ينظر إليها على أنها خلو من أية قيمة علمية. فإنى أبعد ما أكون عن عدم الاعتراف بأهميتهم كمفكرين، ولا بإسهاماتهم في التصدى للمركزية الأوربية. بل على العكس من ذلك تماما: فإن ما أهدف إليه هو ضرب من النقد التضامني معهم، أي النقد البناء الذي هو خليق بأن يشجع الأحياء منهم، ومن ثم حوارييهم كي يصوغوا اعتراضاتهم على المركزية الأوربية على أسس أكثر اتساقا وصرامة.
قبل أن أختم هذه الدراسة أود أن أشير إلى أنه فضلا عن ذرائع المركزية الأوربية التي استنفرت نقدي لها، والتي يعود الفضل فيها إلى كل من كورتيوس وآورباخ وتابعهما فيلك، فهنالك بالمثل محاولات أخرى تسعى لـ "إثبات" وجود "أدب أوربي" (بالمفرد)، من بينها محاجة الراحل فويدا، عضو معهد الأدب في أكاديمية العلوم في بودابست، إذ حاول أن يثبت أن ما يميز الأدب الأوربي عن سواه هو ما لا تعرفه سوى الحضارات الغربية، وهو المسرح.
ولقد تصديتُ للرد على هذا الادعاء فى دراسة لي (نشرت بالعربية والانجليزية) عنوانها: "إشكالية النموذج في المسرح المعاصر". ووردت ضمن فصول كتاب "من التداخل إلى التفاعل الحضاري" سلسلة كتاب الهلال، القاهرة 2001.
• أ. د. مجدى يوسف: أستاذ الأدب المقارن في جامعة القاهرة (سابقا)، ورئيس "الرابطة الدولية لدراسات التداخل الحضاري" بجامعة بريمن. وقد ألقى نص هذه البحث في أصوله الأولى على هيئة محاضرة عامة دُعى لإلقائها في جامعة دبلن (المعروفة بـ "ترينتى كوليدج دبلن") في نوفمبر عام 2000، كما قررت جامعة "لا سابينزا" في روما نص هذه الدراسة بعد ترجمتها ونشرها بالإيطالية على طلبة الأدب المقارن بها.