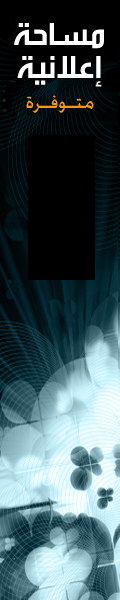لعلَّ كتاب "حوادث دمشق اليومية" هو من أشهر المؤلفات التي تحدثت عن هذه المدينة في فترة معينة، فهو يتناول واقع هذه العاصمة في أواسط القرن الثامن عشر، ويعرض لتاريخ هذه السنوات الإحدى والعشرين، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، في مزيد من التفصيل والوضوح، حتى يمكن القول أنه من أهم المراجع للاقتراب من صورة دمشق في ذلك الزمن، إن لم نقل أنه أهمها على الإطلاق.
مقدمة محقق الكتاب:
والواقع أن هذا الكتاب قد مرَّ بثلاث مراحل قبل أن يصل إلى أيدينا في صورته الراهنة.
فحوالي منتصف القرن الثامن عشر بدأ بكتابته الشيخ أحمد البديري الحلاق. وفي أواخر القرن التاسع عشر، تناوله الشيخ محمد سعيد القاسمي بالتعديل والتهذيب. وعام 1959 ظهرت طبعته الأولى مع مقدمة ضافية وافية بقلم الدكتور أحمد عزت عبد الكريم أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس في القطر المصري الشقيق. وكان هذا المؤرخ قد أقام زماناً في دمشق، قدره ثلاث سنوات بين عامي 1946-1949 كان هذا الكتاب ثمرتها اليانعة الشهية.
لم يكن مؤلف "حوادث دمشق اليومية" الشيخ أحمد البديري الحلاق، سوى حلاق كما يدل على ذلك اسمه. إلا أنه كان يمارس مهنته في زمن انعدمت فيه وسائل رواية الأخبار من صحف أو إذاعة. وكان الزبائن الذين يقبلون عليه كما يقول الدكتور عبد الكريم يسمعون كثيراً ويروون كثيراً.. وهكذا فإنهم كانوا كل يوم يقدمون له المواد التي يسجلها في دفتره، بعد أن يغلق دكانه منهياً عمله، ولقد كتبها بأسلوبه الذي تشيع فيه العامية..
وبقي هذا الكتاب نسياً منسياً أكثر من مئة سنة، حتى عاد إلى الظهور في القرن التالي: التاسع عشر.
إن محقق الكتاب الدكتور أحمد عبد الكريم يقدم روايتين اثنتين حول كيفية وصوله إلى الشيخ القاسمي، وقد سمعهما من الباحث السوري في الآثار محافظ المتحف الوطني بدمشق، الراحل أبي الفرج العش.
قيل أولاً أن الشيخ محمد سعيد القاسمي أراد يوماً أن يبتاع شيئاً من عطار فوضع له العطار ما باعه في ورقة مكتوبة، وحين عاد إلى البيت ففتح الورقة وقرأ ما فيها، أدرك أنها جزء من مخطوط تاريخي، فعاد فوراً إلى العطار وحصل على جميع الأوراق الباقية من الكراسة.. ولم تكن هذه سوى مخطوط البديري "حوادث دمشق اليومية".
أما الرواية الثانية فتقول أنه استعار هذا المخطوط من الشيخ طاهر الجزائري.
وكان هذا قد اشتراه في مزايدة عقدت لبيع مكتبة الشيخ محمد المنيِّر أحد علماء دمشق في القرن التاسع عشر بعد وفاته.
وبعد أن اطلع القاسمي على المخطوط استأذن صاحبه أن ينسخه فأذن له.. فإذا هو يغتنم الفرصة، فيعمد إلى تنقيح الكتاب.. وتحسين أسلوبه بعد أن كان مكتوباً باللهجة العامية الدمشقية.
اليوميات خلال 21 سنة:
يحفل الكتاب بالأخبار التي جمعها أحمد البديري الحلاق في الفترة التي كان يسجل فيها حوادثه وقد استغرقت واحداً وعشرين عاماً بين سنتي "1741-1762م" و "1154-1175هـ" وكاد المؤلف أن يحصر اهتمامه بتدوين ما يجري في دمشق وحدها، من تولي الباشوات وكبار أصحاب المناصب، وعزلهم ومصادرة أموالهم كالمتسلم، أي مندوب الباشا لإدارة الولاية أثناء غيابه، والد فتدار أي المشرف على الحسابات المالية والقاضي والمفتي وآغوات العسكر، وهذه رتبة عسكرية. أضف إلى ذلك أنباء الحج، وطلوع موكب الحج من دمشق وعودته إليها، وما جرى له في الطريق، وفتن الجنود، ونهوض الأسعار واضطراب الأمن وفساد الأخلاق وانتشار الأمراض وغزو الجراد.. وحدوث ظواهر طبيعية من ريح شديد وخسوف وكسوف.. وفيضان وزلازل.
ويلاحظ الدكتور عبد الكريم أن أنباء الحج حازت على جانب كبير من اهتمام البديري، فقد كان يتتبعها كل سنة ويبدأ تسجيلها، بعد أن تتحرك قافلة الحجاج في أثر المحمل.. ويواصل هذا الاهتمام، بكل ما يمكن أن ينطوي عليه من تفصيلات وأخبار.. حتى تعود القافلة إلى دمشق.
غير أن هؤلاء الحجاج ليسوا أناساً من دمشق وحدها، بل إنهم يأتون من جميع أنحاء سورية، وليسوا هم وحدهم فحسب، ذاك أن دمشق في موسم الحج تغدو مركزاً كبيراً يتجمع فيه الحجاج من بلاد العجم وإيران وما وراءها وتركيا وآسيا الوسطى. وربما كان هذا هو ما أضفى على دمشق هذا الطابع من القدسية حتى دعوها "شام شريف".
جبر خاطر لعموم الناس:
يقول الدكتور عبد الكريم:
"اعتاد أكثر الحجاج الغرباء أن يحملوا معهم كثيراً من منتجات بلادهم لبيعها في دمشق، كي يستعينوا بثمنها على أداء نفقات الحج. وكثيرون منهم يبادلون بمنتجات بلادهم منتجات سورية. وهكذا كانت خانات دمشق وأسواقها تمتلئ بخليط عجيب من الناس والأصناف والإبل والخيل ودواب الحمل فتروج فيها حركة التجارة.
وكان أهل دمشق ينتظرون وصول قافلة العجم باهتمام كبير خصوصاً إذا كانت كبيرة العدد، فإنهم يحضرون معهم "ربيات" ذهباً ولؤلؤاً كبيراً وصغيراً وأحجاراً ومعادن وشالاً، فيحدث على حد تعبير البديري "جبر خاطر لعموم الناس في البيع والشراء".
وكان وزير دمشق، أو الباشا، مسؤولاً عن ضبط الأمن فيها خلال وجود هذا العدد الكبير من الناس فيها. وكان يراقب الأسعار لئلا يرفعها التجار فيؤذوا أهل المدينة وضيوفها.
وكان عليه أيضاً أن يعدّ قافلة الحج والمحمل الشريف. وأن يؤلف القوة العسكرية التي ستصحبهما، وأن يدافع عنهما ضد أي اعتداء يحتمل أن يشنه العدو في الطريق.
وبين مهمات وزير دمشق في رعاية الحجاج إعداد الآبار في الطريق للشرب، وتأليف عشائر البدو بالهدايا والأموال. وربما وجد في الطريق متاعب وصعوبات لم يحسب لها حساباً. وكان هذا كله هو الذي جعل مسؤولية وزير الشام بوصفه أميراً للحج الشامي، خطيرة إلى درجة إقالته من منصبه في حال فشله كما يوضح البديري الحلاق.. في كتابه هذا.
أمير الحج.. شخصية أخرى:
في المقدمة الضافية التي وضعها لهذا الكتاب، الدكتور أحمد عزت عبد الكريم، يقدم حديثاً وافياً عن هذه المناسبة في دمشق، أي الحج، وقد كانت لها طقوس كثيرة، وأحيطت بمزيد من الإجلال والحفاوة، بل إنه يذهب إلى أن شخصية أخرى ظهرت في القرن السابع عشر وهو القرن الذي سبق الزمان الذي كتب فيه البديري يومياته، كان صاحبها يدعى: أمير الركب. لقد أحدثت هذه الوظيفة إلى جانب أمير الحج، ولا تعلم بالدقة اختصاصات صاحبها، وكان أحد الباشوات العثمانيين أو من رؤساء الجنود، إلا أنه كان على كل حال أمير ركب محمل الحج وقائد الجند الذين يصحبون المحمل لحراسته، وفي الآن ذاته كان باشا الشام أميراً على القافلة كلها، بمن فيها من مدنيين وعسكريين.
ومهما يكن من أمر، فإن هذا المنصب اختفى في القرن الثامن عشر، وأصبح باشا الشام أمير الحج وأمير الركب معاً.
وكما يقول الدكتور عبد الكريم فإن الاستعدادات لخروج الحج تبدأ قبل حلول موسمه بثلاثة أشهر وحينذاك، يقوم الباشا بجولة تفتيشية كانت تسمى "الدورة" ويتولى خلالها مع جنده تفتيش عدد من الجهات، لجمع أموال من سكان المناطق الجنوبية في فلسطين والأردن يستعان بها في إعداد قافلة الحج والمحمل، ولإظهار سطوة الدولة في هذه المناطق التي ستمر فيها قافلة الحجاج.
في الأسبوع الأخير من شهر شعبان يبدأ توارد الحجاج البعيدين إلى دمشق، حتى إذا كان شهر رمضان امتلأت دمشق بهم. وفي منتصف شوال تبلغ الترتيبات النهائية لقافلة الحج ذروتها، فيخرج أمير الحج من سراي الحكومة قرب القلعة على رأس موكب المحمل ويتخذ طريق الميدان، متجهاً إلى قرية المزيريب في حوران. وبعد أقل من أسبوع تتوالى قوافل الحجاج في السفر: قافلة الحج الشامي، فالحلبي، فالعجمي.. ويتجمعون في المزيريب، حيث يقضون بضعة أيام يستعدون خلالها للرحلة الكبرى إلى الحجاز، فيبيعون ويشترون، وينظم الباشا جنوده ويستطلع الطريق.
قافلة الجردة: 22 يوماً:
وفيما يتجه الحجاج إلى بيت الله الحرام، فإن الاستعدادات تبدأ لاستقبالهم بما يسمى: الجردة. وتنتدب الدولة أحد وزرائها أو ولاتها لإعداد قافلة الجردة، وتتألف من مؤن غذائية وشعير وعليق للدواب، وحبال وملابس.. تعد لإسعاف الحجاج في طريق عودتهم إلى الشام خشية أن يكون ما عندهم قد نفد.
وتمضي قافلة الجردة مع رئيسها: سردار الجردة، اثنين وعشرين يوماً في الطريق، ثم تصل إلى مكان شمال المدينة المنورة يسمى: هدية. وهناك يكون اللقاء بين قافلة الجردة وبين الحجاج.. وبعد أيام يبدؤون جميعاً طريق العودة. وإذ يقتربون من دمشق، فإن أمير الحج يرسل أحد رجاله يدعى الجوخدار أو الجوقدار ليبشر بوصول الحجاج سالمين أو ليطلب النجدة إن كانت القافلة قد تعرضت للعدوان.
يقول الدكتور عبد الكريم: إن رحلة الحج لم تكن نزهة، فقد كان الحجاج يقضون في الرحلة كلها زهاء أربعة أشهر من شوال إلى صفر، وكانت الرحلة حقاً قطعة من العذاب، ومدوّنات تلك الأيام تفيض بما كان يلقاه الحجاج من أخطار الطريق، من ظواهر طبيعية لا يستطيعون لها دفعاً كالحر اللافح أو البرد القارس أو السيل الجارف، أو من عدوان بعض الناس فيموت منهم الألوف... ويعود الباقون في أشأم حال. بينما يظل الناس في دمشق يتنسمون أخبارهم، حتى إن بعضهم يخرج إلى ظاهر المدينة عند باب الله، في الميدان، يستطلعون أنباءهم.
كوارث ومشقات في الطريق:
وقد تحدث البديري عما لقيه الحجاج من أخطار في بعض السنوات، فسنة 1156هـ وكانت تقابل عام 1743-1744م: "فجاء خبر عن الحج الشريف بأنه غرق في "الحسا" وذهب على ما قيل مقدار نصف الحجاج من خيل وجمال وبغال، ونساء ورجال، وأموال وأحمال.
ومضى الحجاج في طريقهم إلى دمشق، فإذا سيل آخر يفاجئهم في البلقاء حتى كاد أن يهلك بقية الحجاج، وبادر الباشا، فأنفذ رسولاً إلى دمشق يطلب النجدة من أهلها فشق شوارعها وهو ينادي:
"يا أمة محمد! من كان يحب الله ورسوله، وتمكن من الخروج فليخرج ومعه ما يقدر عليه من مأكل ومشرب وملبس".
فخرجت الخلق مثل الجراد، كما يقول البديري.
وقد يضطر أمير الحج أن يتنكب الطريق الرئيسي حيث تقوم آبار الماء وتتوفر المياه، إلى طريق آخر، ليتجنب عدواناً يدبره بعض اللصوص. وقد حدث في إحدى المرات أن الحجاج لم يجدوا ماء في الطريق الآخر، فأصابهم الظمأ حتى توفي منهم في يوم واحد ألف ومئة حاج. ومثل هذا كثير على حد تعبير البديري.
ويختم محقق الكتاب هذا الحديث عن الحج بذكر التغييرات التي طرأت على إجراءات الحج في منتصف القرن التاسع عشر، ومنها التحول إلى استخدام البحر الأحمر، ابتداءً من عام 1858، حين حلَّت السفن البخارية محل السفن الشراعية في نقل الحجاج بين السويس وجدة، ثم كان إنشاء الخط الحديدي بين الاسكندرية والقاهرة والسويس، وشقَّت بعدئذ قناة السويس، فكان الحجاج الآتون من تركيا يفضلون الإبحار إلى بيروت أو الاسكندرية. واستخدم الحجاج الإيرانيون طريق خليج البصرة إلى جدة. ولكن أعظم انقلاب في الحج، كان إنشاء سكة حديد الحجاز عام 1908، فبطل طريق القوافل تماماً.
دمشق أواسط القرن الثامن عشر:
انطوت يوميات البديري الحلاق في كتابه هذا، على وقائع كثيرة غريبة، يمكن أن نرى أنها من حيث دلالتها الأخيرة، خير شاهد على الحالة الاجتماعية- الثقافية التي عاشها الناس في دمشق في أواسط القرن الثامن عشر الماضي. فإن هناك ربطاً غير عادي، بين بعض الظواهر الاجتماعية كفساد الأخلاق مثلاً على حد تعبير واضع الكتاب، وبين بعض الكوارث الطبيعية كالسيل والزلازل والجراد.. وهو يرى أن هذه جاءت نتيجة لتلك وعقاباً عليها. وهناك أيضاً إيمان بالخوارق والغيبيات. ففي أحداث عام 1159هـ الموافق للسنتين الميلاديتين 1746-1747 وصل الجراد إلى الشام، فنزل على بساتينها "فأكل حتى لم يبقِ ولم يذر" فماذا كانت النتيجة؟ يوضح الكاتب أن الباشا والي الشام أرسل رجلين من أهل الخبرة كي يأتياه بماء السمرمر. وفي السنة التالية 1160هـ عاد الجراد إلى الظهور في الشام وأراضيها.
يقول البديري: "فلما جاء فصل الربيع صار يظهر شيئاً فشيئاً، إلى أن ظهر مظهراً شنيعاً وبدأ يزحف مثل النمل والذرّ، فبدأ يأكل الزرع ويتلف النبات، فوقعت الناس في كرب عظيم، فنبَّه حضرة أسعد باشا حفظه الله على الفلاحين عموماً بأن تجمعه وتأتي به.
وقد فرض على الأراضي الخمس –أي التي يحتاج ارواؤها إلى جهد كاستخدام الروافع أو السدود ويجبى منها خمسة بالمئة من غلتها –كل أرض قنطارين. وكذلك القرى والضياع، كل ضيعة فرض عليها شيئاً معلوماً يجمعونه. فجيء به –أي الجراد- أحمالاً وأمر به أن يدفن" وظل والي الشام أياماً كثيرة يتابع طريقته هذه في مكافحة الجراد، مع فرض الجزاء على المخالفين، حتى أنهم في ثلاثة أيام وضعوا في الصالحية ألفاً وسبعمئة قنطار من الجراد، عدا ما وضع في المغاور والآبار في غير الصالحية.
المشايخ وأهل الطرق.. والسمرمر:
ولكن ماذا عن ماء السمرمر:
إن محقق الكتاب الدكتور عبد الكريم يتحدث في إحدى الحواشي عن نوع من الطير يدعى بهذا الاسم وكان الناس يعتقدون أن هذا الطير يفتك بالجراد، فكانوا يحرصون على الإتيان به إذا نزل الجراد بأرضهم، ولكنه في اعتقادهم لا يأتي إلا تابعاً نوعاً خاصاً من الماء يُجلب خاصاً من عين بين أصفهان وشيراز. فإذا نزل الجراد بأرض، جُلب إليها من تلك العين ماء بحيث أن حامل الماء لا يضعه على الأرض ولا يلتفت وراءه فيبقى طير السمرمر على رأس حامل ذلك الماء كالسحابة السوداء إلى أن يصل إلى الأرض التي فيها الجراد فتقع الطيور عليه وتقتله. وقيل: من شرطه أن يكون حامل الماء من أهل الصلاح.
ويرى الدكتور عبد الكريم أن اعتقاد الناس بالسمرمر وماء السمرمر ظلَّ قائماً حتى زمن متأخر، وهو ينقل عن الأمير حيدر الشهابي أن أسراباً من الجراد أغارت على بلاد الشام سنة 1816 وأهلكت الزرع، حتى أرسل الله له السمرمر، ففقس في أرض وادي التيّم وغير أماكن، ثم لحق الجراد بعد طيرانه فاختفى وأراح الله العالم منه.
ويتحدث البديري عن يوم وصل فيه ماء السمرمر، وهو يوم الاثنين رابع عشر رجب عام 1159 فيقول: جاؤوا بماء السمرمر وطلعت لملاقاته المشايخ وأهل الطرق بالأعلام والمزامير وطبول الباز، ودخلوا بموكب عظيم بكت فيه خلق كثير، وعلقوه بمنارة الشيخ الأكبر في الصالحية، وفي منارة تكية المرجة السليمانية، وفي منارات الجامع الأموي، وأبقوا في السرايا قُرَباً من ماء السمرمر.
كثر الجراد وأضر بالعباد:
ويبدو أن جمع الجراد، ومكافحته بالسمرمر... مرَّا دون نتيجة تذكر، ذاك أن هذا المؤرخ الشعبي يقول "في تلك الأيام كثر الجراد وأضر بالعباد وكأن الناس لم يجمعوا منه شيئاً، وهذا كله مع ازدياد الفجور والفسق والغرور والشرور، فخرج الشيخ إبراهيم الجباوي ومعه التغالبة بالأعلام والطبول وقصدوا زيارة السيدة زينب واستغاثوا عندها بكشف البلاء عن العباد. ورجعوا آخر النهار، ثم داروا حول مدينة دمشق، ومروا أمام باب السرايا، وعملوا "دوسة" وصار حال عظيم وبكاء شديد، وشعلت الرجال القناديل، وهم يدعون بهلاك الجراد ورفع البلاء. وبعد يومين جاءت أهل الميدان بطبول وأعلام وحال وصريخ وقصدوا جامع باب المصلى بالدعاء برفع الجراد وهلاكه".
.. ولكن ما هي "الدوسة" التي يقول البديري أنهم لجؤوا إليها فيما فعلوا لدفع أذى الجراد؟
الدوسة.. والطريقة السعدية:
الدوسة، كما يعرِّفها الدكتور عبد الكريم هي احتفال كان يقيمه رجال الطريقة السعدية في مولد النبي (() وبعض الأولياء، فكان عدد من رجال هذه الطريقة ينبطحون أرضاً على وجوههم، ثم يمرّ شيخ الطريقة فوقهم ممتطياً جواده يقوده اثنان من أتباعه، فيدوسهم واحداً بعد آخر ولا يصيب أحداً بضر. وهذه كما ترى دائرة المعارف الإسلامية كرامة من كرامات الطريقة وشيخها... وقد كانت تقام أيضاً كلما اشتد الكرب بالناس، مثلما حدث تلك السنة إذ هجم الجراد... وتردت الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في دمشق.
في مثل هذا المناخ الفكري المتخلف والحالة الاجتماعية المتردية.. تصاب المحاكمة المنطقية بالعطالة ويغدو الذهن جاهزاً لتقبل الشائعات وتصديقها... دون إعمال الفكر بالنظر فيها وغربلتها. وهكذا كما يذكر البديري شاع خبر في دمشق أن امرأة تحتال على الرجال والأولاد، فخاف الناس وكثر الفزع، ولم تمض أيام كثيرة حتى قبض العامة عليها، وخلفها الأولاد والرجال يضربونها ضرباً موجعاً. وعند مثولها أمام القاضي قالت:
"والله يا سيدي أنا امرأة فقيرة الحال ولي أولاد وعيال، وهذا القول عني زور وبهتان". فأمر القاضي بتفتيشها وتفتيش بيتها، فلم يجدوا معها شيئاً يذكر، ولم يعثروا في منزلها على غير متاع عتيق وقطعة من الحصير. وشهد الجيران أنها امرأة فقيرة... فأطلق سراحها ومضت.
ويقدم هذا الكاتب العفوي رجلاً من محلة القبيبات –كانت في آخر حي الميدان- فيصفه بأنه مبارك، من كراماته أنه رأى يوماً رجلاً يبيع علب لبن، فطلب علبة منها، ولما أعطي إياها رفضها، وأشار إلى علبة معينة، فأخذها، ثم لم يلبث أن أفرغها على الأرض فخرجت أفعى، فتركها ومضى.
حين أقام الدمشقيون في الخيام:
بين الأحداث الهامة التي يؤرخ لها البديري الحلاق في هذا الكتاب، الزلزال الذي وقع عام 1759 للميلاد وأشار إليه كمال الدين الغزي في تذكرته الكمالية، وسقطت أثره أبنية كثيرة وقتل عدد كبير من الناس، وكان بين ما تهدم وسقط، رؤوس عدد كبير من مآذن المساجد في دمشق وقبابها، وبينها قبة النسر في الجامع الأموي وثلاث قباب من خان أسعد باشا في البزورية. ويوضح البديري أن هذا الزلزال قد تجدد، مثلما كان الغزي قد ذكر، واشتدت الرياح وتساقُط المباني حتى غادر دمشق أهلها... وأقاموا شهوراً في الخيام خارجها، حتى هدأت عوارض الزلزال تماماً.
ولقد وقعت زلزلة بدمشق، كما يقول البديري عام 1757 م، وكانت أخرى سبقتها عام 1754م إلا أنهما لم تكونا في شدة زلزال 1759 ولم تستمرا زمناً كالزمن الذي استغرقه هذا الزلزال الفاجع طوال عشرين يوماً.
وهو يحدثنا عن كسوف الشمس الذي كان وشاهده أهل دمشق في التاسع والعشرين من رجب عام 1161 للهجرة وسنة 1748 للميلاد. يقول البديري:
"كسفت الشمس حتى أظلمت الشام ورأت الناس النجوم كما تراها في الليل، ومكثت مكسوفة إحدى وعشرين درجة. وصلّت الناس صلاة الكسوف في الجامع الأموي.
... وبعد خمسة عشر يوماً، ليلة الجمعة رابع عشر من شعبان، من هذه السنة خسف القمر خسوفاً بليغاً، حتى لم يظهر منه شيء، وكان ذلك في الساعة السابعة من الليل".
كما هو معروف حسب التوقيت القديم فإن الساعة السابعة تجيء وسط الليل.
قصر العظم وقصة النهب المنظم:
وفي الحقيقة فإن بين الأحداث الهامة التي أرَّخها الشيخ البديري بناء قصر العظم. ولقد روى قصة إقامة هذا المبنى بالتفصيل بين يوم وآخر، من الأيام التي سجلها في دفتره. وإنما يحتل هذا القصر أهمية خاصة، إضافة إلى قيمته التاريخية، ذاك أنه مثال لا يقلد عن البيوت الشامية من حيث اجتماع كل الخصائص من فن البناء والهندسة والتزيين والمرافق.
وقبل أكثر من مئة وعشر سنوات، حين وضع نعمان قساطلي كتابه "الروضة الغناء" ونشره في بيروت عام 1879 أورد فيه أن قصر العظم يحتوي على أجمل القاعات الشرقية وفيه برك واسعة قلما يوجد نظيرها، ويقصد هذه الدار أهل السياحة للفرجة على حد تعبير القساطلي.
ويستطرد قائلاً: إن فيها ثلاثمئة وستين حجرة بين سفلية وعلوية.
أما الأستاذ نجاة قصاب حسن، فقد نشر مقالة في مجلة العمران الصادرة عن وزارة الإسكان في دمشق، تكلم فيها عن قصر العظم بوصفه داراً دمشقية فقال:
"في هذه الدار لا توجد نوافذ على الطريق، بل إن لها باباً كبيراً، له بوابة صغيرة، ومن بعدها تدخل، فإذا أنت في جناح لاستقبال الضيوف اسمه: السلاملك، من السلام، ومن بعده يبدأ قسم آخر هو "الحرملِكْ" من الحرم والحريم أي: مكان النساء".
ثم ينتهي الأستاذ قصاب حسن إلى أن بناء قصر العظم هو قصة النهب المنظم للشعب حتى تتكدس الثروات وتقوم معالم الجمال.
لقد بدأ أسعد باشا العظم بناء قصره عام 1163هـ وانتهى منه عام 1174هـ، أي أن ذلك كان بين عامي 1750 و 1761 للميلاد. وكان حاصل ما أنفقته أجوراً للعمال فحسب أكثر من أربعمئة مليون ليرة سورية تقريباً بعملة هذه الأيام!
أسعد باشا يأخذ دار معاوية:
يقول الشيخ البديري:
وفي تلك الأيام أخذ أسعد باشا دار معاوية، والمقصود هو قصر الخضراء، وأخذ ما حولها من الخانات والدور والدكاكين وهدمها وشرع في عمارة داره: السرايا المشهورة التي هي قبلي الجامع الأموي. وجدَّ واجتهد في عمارتها ليلاً ونهاراً. وقطع لها من جملة الخشب ألف خشبة، وذلك ما عدا الذي أرسله له أكابر البلد والأعيان من الأخشاب وغيرها.
ورسم على حمامات البلد أن لا يباع "قصر ملّ" لأحد، بل يرسَل لعمارة السرايا القصر ملّ يعادل الاسمنت في أيامنا هذه – واشتغلت بها غالب معلمي البلد ونجَّاريها وكذلك الدهانون، بل قل إن يوجد معلم متقن أو نجار أو دهان إلا والجميع مشتغلون بها.
ِ"وجلب لها البلاط من غالب بيوت المدينة. أينما وجد بلاطاً أو رخاماً وغير ذلك مثل عواميد وفساقي –جمع فسقية وهي بركة الماء- يرسل فيقلعها ويرسل القليل من ثمنها".
حجار بصرى وأعمدتها الرخامية:
ويتابع البديري الحلاق في شيء من التفصيل وصف ما فعله أسعد باشا العظم حتى استكمل بناء قصره الشهير. فلم يقتصر أذى هذا الوالي، على نهب الدور والأماكن العامة والمرافق في دمشق، بل تجاوز ذلك، إلى حيث كان يصل إلى سمعه أن في موقع كذا مبنى يصلح لأن ينهب منه شيء.
من ذلك مثلاً، كما يقول البديري الحلاق أنه نقل من قرية بصرى شيئاً كثيراً من الأحجار وأعمدة الرخام. وأخذ من مدرسة الملك الناصر التي في الصالحية أعمدة غلاظاً، جيء بها على عربات تجر بالبقر وهدم سوق الزنوطية الذي كان فوق حارة العمارة، وكان كلُّه أقبية معقودة فأمر بفكه ونقله إلى هذا الدار –القصر. ونقل إليها أيضاً أعمدة من جامع يلبغا. "ومهما سمع ببلاط بديع أو أعمدة أو أحجار من أي محل، كان يأتي بها شراء أو غير شراء".
ولكي يوضح البديري إلى أي درجة كان أسعد باشا مستغرقاً في بناء قصره، منصرفاً عن شؤون الدولة والناس، يتحدث عن جريمة بشعة، وقعت في سوق البزورية قرب موقع بناء القصر، فلم يأبه بها هذا الوالي.
يقول الشيخ أحمد البديري:
"هذا ووزير الشام مشغول بعمارة داره، ولم يلتفت إلى رعاياه وأنصاره. ويقول: ائتوني بحجارة المرمر والرخام والسَّرو".
ويتابع هذا المؤرخ قائلاً:
وتفننوا في البناء والنقوش والتحلية بالذهب والفضة وجلب عواميد الرخام على العجلات والبقر.. من بصرى.
وهذا يعني أن أسعد باشا، أمر بأن تمد أيدي النهب إلى ذينك الصرحين الأثريين العظيمين في بصرى: القلعة والمسرح.
توقف أعمال البناء في دمشق:
وخرّب أيضاً سوق مسجد الأقصاب واستجلب جميع ما فيه من أحجار وأخشاب.
"وكلما سمع بقطعة أو تحفة من رخام أو قيشاني أو غيرها، يرسل فيأتي بها، سواء رضي صاحبها أم أبى.
ويذكر البديري كلمات توضح أن أسعد باشا سخَّر معظم المشتغلين في مسائل البناء والعمارة في قصره. ذاك أنه إذا أراد أحد أن يعمِّر أو يرمم فلا يجد معمارياً ولا نجّاراً ولا خشباً ولا قصرمل... ولا أحجاراً. ولكن كل شيء موجود في القصر الجديد.
ويبدو أن أعمال البناء والعمارة، كانت تحتاج إلى مياه كثيرة، ولذلك فإن الوالي لم يأبه بأن تقطع مياه نهر القنوات التي كانت تروي قسماً كبيراً من مدينة دمشق كي تذهب إلى قصره.
قطع مياه الجوامع والحمامات:
يقول المؤرخ البديري:
وقد أخذ حضرة الباشا قدراً وافياً من ماء القنوات، فما وصل إلى السرايا حتى تقطعت السبل –أي المياه التي يشرب منها الناس في الطريق- وتقطعت مياه غالب الجوامع والحمامات، وبقي ماء القنوات مدة مقطوعاً من غالب البيوت.
ولا يفوت البديري أن يلمِّح في إشارة خاطفة إلى الضحايا الذين سقطوا في أثناء بناء القصر، وقد ورد ذلك في حديثه عن "الدار" كما يحب أن يسمي هذا القصر، بعد أن اكتمل البناء.. يقول البديري:
وبينما النجارون يرفعون السقائل لأجل رفع الطوان وقع ثمانية أنفار منهم فتهشموا، ولم يقتل ولله الحمد منهم أحد. فأمر حضرة الباشا أن يُرسلوا إلى بيوتهم، وأعطى كل واحد منهم نصف ذهبة.
أما الطوان الذي سقط هؤلاء النجارون، فيما كانوا يحاولون رفعه، فإنه السقف المزخرف من الخشب أو القماش السميك ليغطي أعمدة السقف أو المناظر غير المستحبة منه.
وهكذا انتهى بناء قصر العظم في تلك السنة 1174هـ-1761م، فكان داراً كما يقول هذا المؤرخ الشعبي "ما صار نظيرها، ولا عمل مثلها، ولا وجد في الكون لها مثيل".
ـــ نصر الدين البحرة