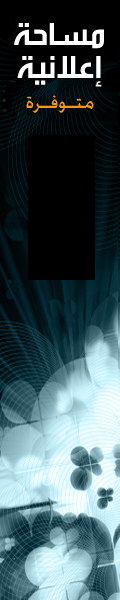1 ـ
لم يبقَ أيُ شيءْ!..
أعرف ذلك جيداً..
فالأمكنة ما عادت هي الأمكنة، والروح ما عادت هي الروح. لا أحد حولي، حتى صديقتي رويداً، بداية أي خلاص غادرتني! أفتقدها الآن كمن يفتقد أنفاسه، أفتقد رنين صوتها الدائم "اصبري يا مريم".. وأهمهم لنفسي:
أصبر… لماذا؟!.. وما من شيء لي قط!!.. لا أحلام ولا خُطا، كلُّ شيءٍ مرمد أو يكاد لكأن الدنيا حشدٌ من الجياد التي هدَّها التعب فأنهكها وقد وصلت إلى نهاية الشوط مطفأة، أبداً لكأن أبواب العالم كلها أُغلقت فأطبق الصمت الثقيل!!
وألوم نفسي وأقرعها طويلاً، أبكي وإياها في عتب مرّ حميم. نتقاود كنديمين أطفأها السهر بالخدر الرخي العذب، يمشيان هوناً على ريث قبيل جهجهة الصبح، يبللهما على مهل ندى عميم، ألوم نفسي وأواسيها، آخذها إليَّ حيناً، وتأخذني إليها حيناً آخر… وعندما يتخافت ضجيجي، وقبل أن يخنقني حزني، أسلّم بأن ما حدث كان، أكبر مني وأقوى!!
- 2 -
أتذكر الآن جيداً،
أنني أحببتُ رويداً منذ رأيتها في المرة الأولى.
أنثى جميلة، طويلة، لها شعر طويل أسود يغطي كتفيها وظهرها بكثافة بادية. كانت أول من أخذني إلى صدره في هذا المكان المربك حالما قذفتني يد السَّجّانة زهية إلى داخل المهجع بقسوة راعبة. لم أنتبه لرويدا التي فاجأتني باحتضانها لي لأنني كنتُ مأخوذةً بطقَّات قفل الباب الحديدي المتعالية، والمتتالية كطلقات الرصاص، وبكلمات زهية الشاتمة الناهرة، لا أدري كيف لم أقوَ على ضبط دموعي، كيف نسيت أنه لابدَّ لي من أن أقاوم عواطفي ومشاعري، وأن أشدَّ من عزيمتي أمام الآخرين، ألا أضعف. كنتُ أعرف أن هذا المكان ليس ديراً، أو مبرة خيرية، فهنا لا رحمة أو رأفة؛ هنا لا حوار أو مداورة؛ هنا قسوة، وحياة زائدة عن اللزوم، الحياة هنا للأبشع والأقسى، والجلود. كنتُ أعرف ذلك، وقد هيأت نفسي له، لكنني الآن أفاجأ بهذه البنت الطويلة جداً، والجميلة جداً، تأخذني إلى صدرها وقد خيّمت عليَّ أنا القصيرة الناحلة؛ تشدّني إلى صدرها كأنني ابنتها أو أختها الصغرى، أحسُّ بدموعي تخالطُ دموعها، هاهي تبكي وتنشج مثلي قبل أن تعرف ما بي! إنها تبكي بحرقة لأنني هنا، فهل عرفتني من قبل؟!.. وأهزُّ رأسي نافيةً! ربما تبكي نفسها فيَّ؛ وقد أذهلها منظري، وشحوبُ وجهي، وضعفُ جسدي، فأستسلمُ إليها كملاذ أخير. أحسُّ بأصابعها تفكُّ منديل رأسي، تنثر شعري، تحتضنُّ وجهي بأصابع يديها الطويلة ؛ تهزّني كشجرة حور صغيرة لأهمهم أو لأضبط بكائي. أراها، أدققُ في وجهها تماماً، أرى خيوط الدمع تتلامع فتزيد عينيها جمالاً، ووجهها اتساعاً وعذوبة، وشفتيها سحراً؛ أرى نظرتها النفوذ، ودهشتها الحيرى. لكأنها فوجئت بوجودي هنا. تهزّني أكثر فأشرق بدمعي، وأحتمي بصدرها كي لا أنهار، فتجمعني إليها بلطف كفلاحة تجمع حبَّ التوت البري في صباح بكر، وتقودني إلى مفرشها، تهبط قبلي على الأرض، فأهبط قربها كالدائخة. تأخذ بحفنة يدها قليلاً من ماء دلوها وتغسل وجهي وجيدي وأطراف صدري، وحين أنتبه جيداً، أرى حولي نساء عدة يحطن بي مواسيات واجمات بعيونهن الدامعة وشفاههن الراجفة. إذن، لم تكن رويدا هي الوحيدة هنا. ولا أدري بعدئذٍ ماحدث لأنني استجبت ليدي رويدا وصوتها، حيث مددتني في مفرشها ونمت. كل ما أدريه هو أنني، وحين استيقظتُ من نوم عميق، وجدت قربي بطانية ومفرشاً، وكيساً فيه دلو صغير وإبريق من البلاستيك الأصفر، وصحن ألمنيوم، وكأس بلاستيكية سوداء، وملعقة. ولم تكن إلى جانبي سوى رويدا التي ابتسمت لها حين رأيتها تبتسم وهي تراقب يقظتي الأولى في هذا المكان المربك القليل الهواء. كانت النساء، من حولنا، راقدات في مفارشهن كأنما حط عليهن النوم مرة واحدة. لم أدرِ كم كانت الساعة لحظتئذٍ، ولم أسأل، لأنني هيأت نفسي وأقنعتها بأن أصعب الأشياء هنا، داخل هذا المكان الكالح، هو مراقبة الوقت أو انتظاره!..
ناولت كفي لرويدا فاحتضنتها بكفيها الواسعتين، وشدت عليها وهي تبتسم. عرَّفتني بنفسها، وأخبرتني بأننا سنتحدث كثيراً، وأن الحياة جميلة وجديرة بأن تعاش. فأبتسم لها، عفواً، أبتسم لكلامها الذي ما عدت أؤمن به، فقد تعاش الحياة مرة أخرى، ولكنها لن تكون جميلة بعدما مضت اللحظات الرائعة بانتظاراتها ومواعيدها الساحرة ولمساتها الذائبة وجداً ولطافةً! أتملَّى وجه رويدا؛ يا إلهي ما أجملها! (بهذا الجمال سنحلي مرارة هذا المكان)..
وأجول ببصري في جميع أنحاء هذا المهجع الرحب، فلا شيء هنا سوى الحيطان العارية لا شيء طري أبداً، لكأننا في مستودع للحطب، كل شيء يباس في يباس، لا طراوة سوى الأسماء، ووجه رويدا وابتسامتها الوسيعة الدائمة، ومع الوقت المديد عرفت قسوة السجانة زهية التي صارت أشبه بالجدار المتحرك لا وجه لها ولا قفا، جدار يتحرك ويقف بالأوامر فقط. لم أرها في يوم من الأيام متخلية عن عبوس وجهها الأشبه بوجه البعير. امرأة أدارت الحياة لها ظهرها فقابلتها بالنكد، والقسوة، والوحدة الموحشة، ومع ذلك فهي لا تزال تصبغ شعرها الأشيب، وتربطه بشريطة كحلية لها ذيل طويل، وتدهن وجهها بالألوان على أمل أن تلتقي بفارس أحلامها المنتظر.
وعرفت رويدا أيضاً! أذكر بأنها قالت لي على عجل بأن قصتها طويلة، سأعرفها منها بالتفصيل، وأنها باختصار شديد قتلت زوجها!.. ورجتني أن أحكي لها قصتي، فقلت: إنها طويلة جداً، لكنها باختصار شديد، هي أنني قتلتُ حبيبي!! وعرفت منها أنها تزوجت من رجل مثَّلَ دور الحبيب، لكنه لم يكن سوى تاجر، استغل جمالها وتعلقها به، فجعلها طُعْماً يؤكل من قبل الآخرين، وعلى علم منه من أجل زيادة أمواله ونفوذه. لقد أحبته بجنون ورضيت أن تفعل كل شيء من أجل أن يبقى لها وحدها، من أجل أن يعطيها الولد الذي تحنُّ إليه! كانت تعرف أخطاءه وتغفر له، وتدرك سقطاته فتتجاوز عنها، وتحسُّ بصدوده وبروده فتعذره، وتتلهف لغيابه لتشتاق إليه، وتنتظر الصباحات التي تنشق عليهما وقد وسَّدَ صدره لرأسها، لكنها اكتشفت، وفي مرة واحدة، أنه متزوج وله أولاد، وأنها ليست بأكثر من طُعم تافه، وسُلمٍ وصل بهما إلى ما يريد. وحين واجهته. اعترف بكل وقاحة بأنه لم يحبها في يوم من الأيام، وأنها كانت من لوازم الشغل ليس إلاَّ. حاولت أن تكذّبه، وأن تكذّب نفسها، أن لا تصدق ما تسمع، لكن الحقيقة ظلّت هي الحقيقة، وحين طلبت منه الخروج وعدم العودة إلى بيتها الذي تعيش فيه معه، أخبرها بصفاقة أن هذا البيت له، وأنه مسجل باسمه، وأنه بإشارة واحدة من أصبعه يرميها إلى الخارج في أية لحظة يشاء. وضاقت الدنيا عليها، فانتظرت بضعة أيام، تأكدت خلالها أن ما من شيء بات مسجلاً باسمها لا البيت ولا المزرعة، ولا روضة الأطفال، ولا السيارة، وأن لا رصيد مالي لها في أي مكان!.. فصغرت الدنيا في عينيها وتباهتت، بكت طويلاً، وحارت بأمرها وقبل أن تستسلم جمعت قواها وواجهته. طلبت منه مبلغاً من المال لتتدبر أمرها، وأن يطلقها بالمعروف، لكنه أبى!… أخبرها بأن لا مال لديه الآن، وأن طلاقها منه سيهزّ سمعته بين الأصدقاء والمعارف. شعرت بأنها مهزومة، وأنها تسقط من علو شاهق في فراغ مرعب. ولم تدرِ كيف تحولت فجأة إلى وحش قضى عليه خلال لحظات فقط، وبذلك انتهى الكابوس بمجيئها إلى هنا!!…
وقلت لها: كان عبودة كلَّ حياتي، التقيته في المشفى مصادفةً. جاء مع أمه المريضة. كنتُ أعتني بها. أعطيها الأدوية والجرعات في مواعيدها، وأجيب عن أسئلتها الدائرة، وكان هو قربها ليل نهار حانياً ذابلاً كعيدان الحبق العطشى. شاب طويل، عريض، حلو…!.. انفتح له قلبي منذ لمحته، وقلت: يارب!! جمعت كفّيَّ إلى صدري، وابتسمت وأنا أرى أيقونة السيدة تهتزّ بارتجافة عميقة، وهمهمت، وأنا أنظر إليه، يارب!!.. كنتُ أتحدث إليه كلما جئتُ إلى غرفة أمه، نقف للحظات قليلة في الممر بعيداً عن أمه والنساء المريضات المجاورات لها في الأسرة ريثما تتم عملية استبدال أربطة الجروح لهن. كان شفيفاً ممتلئاً بالحزن كراهب عذّبته نزوات الحياة. يحكي فلا تصير همهماته كلاماً، ولا تكتمل حكايته. رجل عطش، كلامه عطش، ونظرته عطشى، لا نهايات عنده، ولا خواتيم، مرتبك حيران في كل لحظة.
كنتُ أشرح له حالة أمه فهي ذاهبة لا محالة لأن المرض الخبيث التهمها أو كاد، وأن أحسن شيء يفعله الآن هو أن يكسب رضاها، أن يكون حنوناً معها، يعطيها كل ما تريده، وأن يلبي رغباتها..
فيبكي!!؟.
أول مرة في حياتي أرى رجلاً يبكي بكلِّ جسده، فأواسيه وأصبِّره. ألتقط دموعه برؤوس أصابعي وأشدُّ على يده خلسة، فيرتعش لكأن تياراً من الكهرباء سرى في أوردته. وحين يهدأ يعود إلى أمه، وأعود أنا إلى عملي. وهكذا ظللنا طوال أيام عديدة. تقرّبت إليه، وتقرّب إليَّ، بعدما عرفت بأنه وحيد لأمه المطلقة منذ كان في العاشرة من عمره، وبعدما عرف أنني أعيش وحيدة في المدينة الواسعة بعدما تركت قريتي وأخواتي الثمانية لأبوين انتظرا الولد السند الذي لم يأتِ، وجئت إلى هنا لأتعلم مهنة التمريض. كان يضيف إلى قصته كل يوم بعض الأشياء والأخبار، وكنت أضيف إلى قصتي أيضاً بعض الأشياء والأخبار، وحين ماتت أمه دفناها معاً، وبكيناها معاً كأمٍ مشتركة. وشعرت آنذاك أنه بحاجة إليَّ فلازمته. فعلاً، كانت تمرُّ به حالات من الكوابيس المخيفة وهو في عزّ يقظته فيفزع ويهيج كالمطارد من أشباح لا أراها. كان يتذكر أمه على نحو مأساوي، فأدركتُ كم كان يحبها، لكنني اكتشفت مع الأيام أنه كان يخبئ تحت هذا الحب أشياء أخرى!..
وامتدّت معرفتي به. تعودَّتُ عليه وتعودَّ عليَّ؛ فظللت قربه، سنوات وأنا أرجوه أن يتجاوز موت أمّه، وأن يُقبل على الحياة، وأن يبدأ من جديد. كنتُ أتدبر أمري وأمره بما أوفره من راتبي الشهري حين بات لا يقوى على العمل. كنتُ أنظّفُ ثيابه وأعدّ طعامه كما تفعل الأمهات لا الزوجات، وأخرج معه إلى النزهات. كان مريضاً فعلاً دون أن يشكو. أحسست أن مصيري ارتبط بمصيره، وأنني لن أنفصل عنه مهما حدث. وفجأة، تعافى، عادت إليه صحته وحيويته فعاد إلى العمل، ففرحت لأنَّ الحياة تعود مرة أخرى، ولأن تعبي لم يذهب سدىً، وحين استقرَّت أحواله تماماً، فاتحته بالزواج، قلت لـه أما آن الأوان لكي نصل إلى النهاية السعيدة، فرفض بشدة وعنف لم أتوقعهما. كان يردد بتكرار موجع، لن أعيد سيرة أمي، وحين ألحُّ عليه، يقول: من الممكن جداً أن أموت، أن أنتحر، أما الزواج… فلا! كنتُ مقتنعة بصدقه وحرارة كلماته، لذلك حاولت كثيراً أن أضطره للحديث عن أمه، عن علاقته بها، عن طفولته، ماذا كان يرى، وأين كان ينام، وهل أحبَّ أمه في طفولته أم في شبابه؟!..
كنتُ أبحثُ عن نقاط الضعف في علاقتهما لتقويتها أو محوها، وكان يتهرب من الإجابة. يدعوني بعنف ألا أفتح جروحه مرة جديدة، أن أبتعد عن أمه. ولم أيأس، فعاودت الحديث في موضوع زواجنا مرات عديدة، كنتُ مدفوعة إلى ذلك لأنني احبه، ولأنني أريد أن أنهض في نظر والديَّ وأخواتي الحاسدات بعدما صرت ابنة مدينة. سألته إن كان يحبني، فقال:
ـ "بجنون"!..
أنتِ سبب حياتي، ولولاكِ الحياة عدم، صفر"!
كان صادقاً بالطبع، أعرفه؛ أعرف دقات قلبه، فأهم شيء فيه أنه لا يكذب، وهذا جمال رجولته فعلاً. وحاولت من جديد، قلت له:
ـ "يا عبودة، إنني أعتبرك دير الله،
إنني أهبُ نفسي لك فاقبلني"!..
ورفض!!
قال لي:
ـ "يكفيني حبك لي؛ ولن أعيد سيرة أمي مع أية امرأة في الدنيا"!!
حقيقة، مرمر قلبي بسيرة أمه التي لم أعرف عنها شيئاً، ومع ذلك احترمت رأيه. كان أمامي مثل المشتهى المحرّم عليَّ، هو أمامي ولا أستطيع أن ألمسه أو أتذوقه. صار النظر إليه يعذّبني ويرهق جسدي وروحي، لذلك قررت أن أبتعد عنه وأنا محافظة عليه..
قلت له: "ـ يا عبودة، يعني لا أمل"؟!..
قال: "أبداً"!!..
قلت: "سأتركك تفكر مدة شهر"!..
قال: "اعتبري الشهر قد مرَّ"!.
قلت: "طيب، ما رأيك"؟!.
قال: ."لن أعيد سيرة أمي مع أية امرأة".
قلت: ."إذن، سأذهب إلى دير السيدة، يا عبودة، أنت تعرفه، سأعمل هناك في خدمة الرب، فأنا ما عدت أطيق البقاء في المشفى وطيفك أمامي في كل الأمكنة، وأنا لا أعرف ماذا أفعل بك"!..
قال: .."لكي تهربي مني"؟!..
قلت: "لا. لكي أحافظ عليك"!..
وصمت، فأضفتُ:
ـ "عبودة، إن غيَّرت رأيك، تعال وخذني من الدير، سأظلُّ منتظرةً لك، أتفهم"!!.
وظلَّ صامتاً أيضاً، فجمعت قواي، واقتربتُ منه، أخذته إلى صدري لأول مرة، وتنشَّقت رائحته لكي تبقى معي، وطفتُ بأصابعي على وجهه وشعر رأسه وصدره، ثم قبَّلته وأنا أرتجف، وخرجت!! وظلَّ هو صامتاً متألماً، لم يقل حرفاً واحداً. وقبل أن أبتعد عن بيته أكثر استدرتُ ونظرتُ إلى نافذته البيضاء المؤطرة بقضبان الحديد الرفيعة، فرأيته كالخيال خلف الستارة ينظر إليَّ بإشفاق شديد، ربما لم يكن وراء الشبَّاك فعلاً لكنني هكذا تخيلته، ويدهُ مرفوعة مشدودة الأصابع تتحرك في تلويحة ملأى بالحنين والألم. لحظتئذٍ، أحسست بحالة من النشيج المؤسي تتعالى خلفي بقوة وصخب كلما ابتعدتُ!..
ـ 3 ـ
ولم أعد إليه، فقد دخلت الدير، ونذرت نفسي أمام الأخوات، لخدمة الرب، لكنني ما نسيته، كان معي في كل شيء، حتى في الصلاة، أنهض في الفجر فأراه أمامي، أصلي أمام الإيقونات فأراه يمرُّ كالطيف بين ألوانها. بل بتُّ أجدهُ في فراشي ليلاً، يسبقني إليه وينام، فأظلُّ إلى جواره ساهرة. أحدق إلى السقف فأراه قرب الصور والأعمدة الملوّنة. وهاجت الروح، وضعفت، فصارحت الأخوات بما أرى، وبما يحدث لي، فلازمتني إحداهن، وجعلتني أكثر من الصلوات، ولم تتحسن حالتي كنتُ أمضي في تخيله أكثر، حتى كدتُ أقنع الأخت الملازمة أنه قربي فعلاً، وأنه أمامي، ها هو ذا يضحك ويخاطبني!…
ولكم كانت تدهش وهي تراني أتبادل وإياه الحديث. وكان أن نقلتْ أخباري للأخوات، فطلبن مني التقوى، والانصراف إلى الأعمال المجهدة نهاراً لكي أنام ليلاً، ولكن كل هذا لم يجدِ، فكان أن قررن أن أعيد تجربة الحياة خارج الدير مرة أخرى؛.. أي أن أفاتح عبودة مرة أخرى بالزواج لعله يقتنع وصلين لأجل ذلك…
وخرجتُّ من الدير فعلاً برفقة إحدى الأخوات، ولم يمضِ عليَّ معهن سوى سنتين أو أقلَّ، كانت هي تحمل بيدها سلةً فيها شراب، ولوز، وزبيب، هدية الدير له، وكنتُ أحمل ثيابي القديمة…
خرجت وإياها مباشرة إلى بيت عبودة، ونحن في ثياب الرهبنة. أحسست أن الحياة دنيا أخرى، عالم آخر؛ عالم فيه عبودة وكفى. كانت مشاعري عارمةً، وخطواتي عجلى، واضطرابي واضحاً. وحين وصلنا، لم أقو على تأمل البيت الذي أحببته، ولم ألمّس على نباتاته الكثيرة، ولم أشاكس طيوره كما اعتدت، نسيتُ كل ذلك، لكأنني أعودُ إلى البيت بعد ألف عام من الغياب والهجر.
ولم أدرِ كيف استطعت أن أدق الباب مرة أو اثنتين على عجل، فانفتح، والأخت الراهبة قربي مذهولة متعجبة من تصرفاتي وكأنها غير مصدقة لما يحدث، وأطل عبودة. يا إلهي، أية رؤية هذه، أي سحر؟!.. عبودة بدهشته الكاملة، ونحولتِهِ الرائعة، ورجفان أهدابه المتواصل، إنه هو هو لم يتغير فيه شيء. وأتقدم نحوه مندفعة، أرمي نفسي في صدره تماماً وقد أشرق وجهي، وهامت روحي، وامتلأ فمي بالهمهمات والتمتمات، ولم يضمني بذراعيه.
كنتُ أُغمغم كالمريضة:
ـ "ها قد عدت يا عبودة،
لم أحتمل غيابك المر. ضمَّني أرجوك"!!
لكنه لم يضمني، وعذرته لأن المفاجأة كانت كبيرةً، مذهلةً حقاً. ولم يقل حرفاً واحداً. بغتةً، فتحتُ عينيَّ فرأيتُ خلفه تماماً امرأة تشدُّ إلى صدرها طفلاً رضيعاً. فجمدت نظراتي. ولفّني الهيجان العنيف، لكأنَّ سحر اللقاء ولَّى دفعةً واحدةً، فسألته بأصابعي:
ـ "من هذه"؟!..
فلم يجب!!
وصرخت المرأة من ورائه حاسمةً الأمر:
ـ "أنا زوجته، أنتِ من؟!"…
ولم أدرِ لحظتئذٍ ماذا حدث! فقد نقّلت بصري بين زوجته وطفلها، والأخت الراهبة التي شرعت تبكي وهي تشدّني إليها، ووجه عبودة الذي اصفرَّ كثيراً بين يدي، لكأنني ضغطتُ عليه أكثر مما ينبغي لأنني ما إن فككت ذراعيَّ عنه حتى وقع على الأرض قرب السلة التي أُفلتت من يد الراهبة فاندلق الشراب، وتبعثر اللوز والزبيب، وقع كتلةً لا حياة فيها ولا أنفاس، لحظتئذٍ ثار عويل، وبكاء، وحزن، وكلام!!..
ولم أعد إلى الدير، بل اقتدت إلى هنا!!
ـ 4 ـ
الآن،
أتذكر هذا كلّه، وهم يسوون أوراق خروجي بعد ما نفق العمرُ وانتهى، وإحساسي يقول لي بأن ما من أحد سيستقبلني مرة أخرى خارج هذا المكان سوى رويدا التي أتخيلها واقفةً إلى جواري ونحن ننظر بدهشة عارمة إلى السجانة زهية وهي ترضع طفلها فوق مقعد خشبي في الحديقة العامة، وصوتها الناهر يتعالى منادياً أولادها كي لا يقفزوا من فوق السياج الشوكي، فأبتسمُ للمشهد؛ وأعود منه وهن يناولنني ورقة إخلاء السبيل!!
حسن حميد