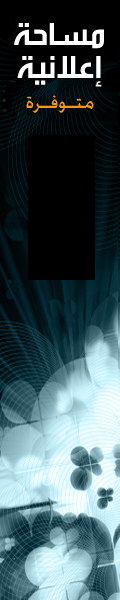ـ 1 ـ
قد اختلف مع غيري إن قلت: إنني بدأتُ الكتابة عن وعي وقصد، وإنني اخترت القصة كما يختار العاشق عشيقته، بحثت عنها طويلاً، ورسمتها في خيالي سنوات عديدة، ولم أسلّم نفسي لها إلاعندما طردت آخر طيف من طيوف الشوق للشعر والرسم والرياضة. وحين واجهتها كانت على انتظاري حنوناً وصعبة، جريئة وخجلى، بادية ومتخفية بأسرارها، لهامهابة تفضح ضعفي، وتبدي ارتباكي!..
كانت ولا تزال عصية عليَّ، لم تمنح أصابعي أو خيالي إلا بعضاً من مفاتيحها التي لا تعدّ، ولكم واعدتني وأخلفت، وكم انتظرتها ولم تأتِ، وكم راسلتها قراءة وشوقاً ولم تجب، ولكم تهيأت لها فظلَّت طيَّ الغياب؛ هكذا كانت وهكذا تظلُّ، وأنا راضٍ ببدوها ونفورها الرغوبين، فغيابها سرٌّ، وبدوها سرٌّ، والحياةُ معها عطش على عطش...
ـ 2 ـ
كنتُ، وأنا في المدرسة الثانوية، أبحث عن ذاتي، عن صوتي داخل حجرة الصف، وبين زملائي في ملعب كرة القدم، وفي البيت بين تسعة أخوة، وعن مكان أشغره الأب الذي ذهب إلى (الفدائية) لكي يعود شهيداً في الخشب الصقيل. كنتُ في حال مرضية من القلق والحمّى واللوبان على مكانة تكون جديرة بي كابن بكر لأم شفوق يذوّبها الحنان حيناً، ويطلقها الخوف وحشاً حيناً آخر لمحاصرة الدلال والرخاوة، والفوضى، والإخفاق الذي تراه طيفاًيلوح هنا وهناك قرب البيت أو مع منطلق الصباح، ولحظتئذٍ ستعاب لانها امرأة لم تعرف كيف تربي ابنها البكر الذي سيأخذ أخوته ركضاً في الدروب العائبة التي اختطها. كم كانت تخاف الفشل والرسوب في المدرسة. أذكر تماماً أنها كانت تجالسنا، وهي الأُمية التي لا تعرف حرفاً من حرف، أو رقماً من رقم، ونحن نكتب الوظائف؛ يجول بصرها الطريد بين الأسطر، ويتنقل بخفة مابين الكتاب والدفتر، تقف على الأصابع الراجفة رضاً حيناً، وخوفاً حيناً آخر، تراقبنا ونحن (نحلُّ) تمارين الإنكليزي والرياضيات، ومسائل الفيزياء والكيمياء بكل الانتباه والحذر، تشدّ بصرها إلى رؤوس ريش أقلامنا؛ تمشي معها حذرة في السطر كي لا ننحدر أو تنحدر، وكي لا نميل أو تميل؛ وتنتهي معنا بانتهاء صفحاتنا أو بانتهاء الأسطر، وتزفر مثلنا كطفلة فرغت لتوها من صنع دمية من طين أو قماش. كم كنا نخافها، فقد كانت أستاذ البيت بامتياز، نخاف كي لا تضبط غلطاً اقترفناه، فإن محونا تسألنا لماذا؟! وإن ارتبكنا أو شردنا تسألنا لماذا؟! وإن ارتجفت الشفاه تمتمة تسأل هلوعة... لماذا؟! كانت أشدّ الأساتذة وأقساهم، ولم تنعتق رقابنا من رقابتها إلا عندما كنا نجتاز امتحان الشهادة الثانوية، فنفر فرحين بحريتنا واحداً واحداً كطيور طال عليها وقت الشتاء!...
كنت، وفي عطلة الصيف، أعمل من أجل (مصاريف) المدرسة، ومن أجل تحسين نوعية الطعام في البيت. فقد كان الوالد فدائياً في جبال عجلون وأحراشها في الأردن، لا يأتي إلينا إلا مرة واحدة أو مرتين في السنة؛ يأتي ولا مال معه؛ كان منظره البهيج مالنا وفرحتنا؛ فنصير نحن أبناء الفدائي الذي جاء بلباس الفوتيك الأخضر و الشماخ الأحمر، والسُمرة المشوية تحت لهب الشمس. يبدو لنا، ولغيرنا أيضاً، كأنه جاء من كوكب آخر، فيأتي الجوار للسلام عليه، ولكم كانت تخجلنا تلك الزيارات لأن أمنا لا تمتلك كمية من الشاي والسكر كافية لاستضافة هؤلاء الزائرين. كان الوالد الذي مرَّ بمدينة درعا [على الحدود السورية ـ الأردنية]، قد جاء ببعض علب الراحة، فنقوم نحن الصغار، وبإشارة من أمنا، بتوزيع بعض قطع الراحة الصغيرة على ضيوفنا الزائرين؛ تلك القطع كانت الشرشف الذي يستر عيوبنا أمام الجوار...
وحين نبحث، نحن الصغار، في كيس الوالد، الفدائي الذي عاد أخيراً، لا نجد سوى الملابس الفدائية، وبعض قطع الملابس الداخلية الرجالية [قطع الغيار]، التي كنتُ ألبس بعضها فتصير عليَّ كالمعطف، كما تلبسها أمي تحت ثوبها الأسود الذي اعتدنا أن نراه؛ ثوبها الأسود الوحيد الذي تغسله في عتمة الليل لينشف كيما تعود إلى لبسه مرة أخرى في النهار. كم كانت تلك الأيام والطفولة صعبة وقاسية... وحلوة..
كنتُ، وفي غياب الوالد، أبحث عن قطع الألمنيوم والنحاس والزجاج المكسور، أجمعها ثم أبيعها بالفرنكات القليلة وأعطيها إلى أمي، وما كنت أدري أن تلك الفرنكات ستصير لبناً وخبزاً وزيتوناً في وجبة الصباح التي كانت تجمعنا، أو قليلاً من الخبيزة، والشومر، والمجدرة في وجبة الغداء، وأنها ستصير أيضاً ندوباً هي مرآتي التي أنظر إليها كلما راودتني حلاوة النفس كي أدير ظهري لكل ذلك الماضي الثقيل. تلك الأيام هي التي شوتني على جمرها؛ ولولاها لما كنتُ أنا البكر درباً سيمشيه أخوتي من بعدي!!
أذكر أن الوالدة كانت تنهرني حين أجلس إلى ورق الكرتون لأرسم؛ وكانت تنهرني حين أُمضي وقتاً طويلاً في لعب الكرة، لقد منعتني في تلك الفترة الذهبية من طفولتي عن عشقي للرياضة والرسم، حجبتني عنهما، وكانت المدرسة تساندها لكي أطيّر آخر شوق من أشواقي للرسم وكرة القدم. كنتُ أعوض بالرسم وألوانه فقدي الألوان الطبيعية في مخيم صغير لم تكفِ مساحتُهُ لتراصف البيوت واتكاءاتها على بعضها بعضاً؛ البيوت التي تبيت وحيدة على قارعة الأزقة الضيقة؛ ذلك المخيم الذي لا حدائق فيه ولا طيور، ولا ألوان؛ مخيم يتآخى فيه الناس مع الأحزان، والفقر، والقطط، والمقابر الوسيعة!...
في ذلك الفرن، والخليط من الثنائيات العجيبة، بدأت أبحث عن صوتي وشخصيتي ومكانتي ومعارفي أيضاً. لم يكن في البيت من كتب سوى كتبي وكتب أخوتي المدرسية والقرآن الكريم الذي ولدنا فوجدناه معلقاً فوق رؤوسنا على مسمار في الجدار؛ تلفّه قطعة قماش أبيض؛ فلا ينزل إلا في أوقات الوفاة أو في ليالي رمضان الساحرة ، أو في بكور أيام العيدين الفطر والأضحى.
قبل أن أكتب القصة قرأت أكثر التجارب الأدبية التي كانت في متناول يدي، وبدأت أنظر إليها بعين المحلل الذي يريد أن يتعلم منها أسرار الكتابة، وليس فقط من يريد أن يصل إلى متعة القراءة أو فحواها. ولذلك كان زادي من القراءة كبيراً قبل أن أكتب القصة. لقد عرفت خريطة القصة ومواقع الأسماء عليها، ورحت أضيف إلى المعلومات التي استحوذت عليها من القراءة معلومات أخرى من العارفين في الأدب والنقد خصوصاً، وبدأت الكتابة بعيداً عن أي توجيه أو أية خطة، أخطأت مرات عديدة، وتعثرت كثيراً، ولم أكن نبتاً شيطانياً أبداً، وبعد حين بدأت أحوز على الرضا أو بعض الرضا الذي كان كفيلاً بأن يجعلني أتقدم في حقل الكتابة القصصية. وبدأت النشر، وقد كان هذا الأمر يعني لي الكثير، ومع كل نشر لقصة جديدة، كنتُ أزداد حماسة واندفاعاً وحباً لهذا الفن الأدبي الرائع.
ـ 4 ـ
منذ بداياتي أخلصت لمعان ثلاثة أجدها ضرورية وجوهرية في الكتابة القصصية، هي الإمتاع، والإقناع، والوظيفية، وأنه لابدَّ من أن تتجاور هذه المعاني، وأن تتداخلْ أو تتماهى بحيث يصير الاقناع متعة، والمتعة والإقناع رؤية وظيفية، أي أنني وجهت كل موهبتي وثقافتي باتجاه أن تقول القصة رأياً ما، وأن تقدم اتجاهاً أدبياً ما، وأن تبدي شكلاً أو أشكالاً من الجمالية الفنية، وأن تؤدي الوظيفة المهدوفة. لكل هذا كنت حازماً وصارماً في قراءاتي لا أهادن ولا أحابي؛ أبحث عن تلك المعاني التي أشرت إليها سابقاً، أو عن طيوفها داخل النص القصصي فإن وجدتها أنتقل إلى مرحلة أخرى كأن أنظر في الأسلوب واللغة أو الاستهلال والخاتمة، وباقي الوحدات الصغيرة التي تكّون النص، أي أنظر في الجماليات التي تماشي الفكرة حيناً، وتديم عمر المتعة حيناً آخر، وتوجد بؤرة القضية أو الهدف حيناً ثالثاً.
على ضوء هذا الفهم، قرأت القصة الفلسطينية والعربية، قرأتها عشوائياً أولاً [حسب ما توافر لي، ثم عدتُ وقرأتُ أبرز أعلامها في فترة الستينيات والسبعينيات (غسان كنفاني، سميرة عزام، يحيى يخلف، رشاد أبو شاور، محمود شقير، خليل السواحري، أميل حبيبي، جبرا إبراهيم جبرا،...الخ)، قراءة واعية قصدية فوجدت أن الاهتمام بصورة عامة انصبَّ كلياً على الخندق، والعملية، والقواعد الفدائية، والشهيد، والشجاعة، والأحزان...الخ، فقد انجرف الكتاب الفلسطينيون نحو إيجاد نشيد مقاوم، هو نشيد الشعب الذي يريد الخلاص من حرائق الماضي، لكن ذلك الانجراف نحو الجريدة المقاومة، والقاعدة المقاومة، والفدائي المقاوم... الخ، جعلهم ينسون البيت الفلسطيني، والأسرة الفلسطينية، والمكان الفلسطيني، والولادات الجديدة التي تحدث في الزمن الفلسطيني الجديد (ولا أقصد بالولادات هنا... المواليد أي الأطفال، وإنما أقصد الوجوه الجديدة التي استحدثتها الحياة الفلسطينية الجديدة، مثل مقابر الشهداء، ومعامل الثورة، والمعسكرات الملحقة بالمخيمات، ومقرات التنظيم، والأنشطة الاجتماعية، والاتحادات النقابية..الخ). لكل هذا، وجهت قصتي القصيرة نحو الناس والمكان والغايات النبيلة، فتحدثت عن المخيّم باعتباره مكاناً استثنائياً، مكاناً طارئاً، أي تحدثت عن البيوت، والأزقة، والمقابر، والنباتات والزروع، وحنفيات الماء، وساحة الأعراس باعتبارها مكاناً لاستنفار الذاكرة. وتحدثت عن قلق الأمكنة الناتج عن قلق الروح الفلسطينية، وعن الفدائي باعتباره بشراً من لحم ودم، يخاف ويحزن، يستطيع ولا يستطيع، يُقدم ويحجم، يحب ويعشق، يكره ويحقد، يصدق ويكذب... الخ. أحسستُ أن نقصاً فادحاً يعوز الكثير من التجارب القصصية الفلسطينية، وهو النقص المتمثل بالروح البشرية، فالأرواح التي رأيتها وعايشتها في تلك التجارب القصصية هي أرواح متفوقة منذ بدوها الأول، لأنها أسيرة لقناعة المؤلفين، أي أنها أرواح مصنّعة ومعدودة على مثال متفوق ليس صالحاً للقياس أو التطبيق أو المقاربة إلا على نحو ضيق تقريباً.
لهذا... حاولت أن أقدم النماذج البشرية التي تعيش إلى جواري في المخيّم؛ كتبتُ عن أمهات الشهداء اللواتي ا نبرت أقدامهن ذهاباً وإياباً مابين البيت ومقبرة المخيم، والدموع التي تملأ عيونهن وهن يشاهدن، كيفما تلفتن، صور أبنائهن ملصقات على الحيطان والأزقة، والأطفال الذين لم يعرفوا آباءهن إلا صوراً معلقة كطوابع زمنية داخل البيوت وخارجها، والحدائق والبيارات التي ابتعدت طيَّ المكان المفتون بالغياب، وطيَّ الزمن المتواري، وقد غدت مضمرة على شكل مشاتل نعناع صغيرة تلوذ بعتبات مداخل البيوت. هالني ذلك التقزم والضمور، وأوجع قلبي... فخضرة فلسطين الباذخة، وبياراتها وشميمها الآسر، وسهولها الوسيعة الأمداء هاهي تغدو مشاتل حبق صغيرة أو عروقاً من النعناع المصفرة، أو شتلات من نباتات العطرة والسجاد، ومجاري المياه والينابيع، والبحيرات تغدو حنفيات شحيحة الماء تدور حولها النزعات والخصومات بعد أن كانت الأنهر والينابيع والغدران وشواطئ البحيرات مواعيد للأمسيات الساحرة، والعشق الحلال، و الكلام الهامس الجميل.
لهذا.. كتبتُ عن البيت الفلسطيني الذي استنبت الفدائي، وعن الأسرة التي ا حتضنته، وعن الأمهات اللواتي أصبحن عرائس وهن في الستينات من أعمارهن بعدما توازعت أولادهن سجونُ (إسرائيل)، ومقابر المخيم. كتبتُ عن الدموع الخرساء التي تجري ليلاً كدموع الشجر، وعن التراث، والأرض، والتاريخ، والأحداث، والأمكنة التي تورّث جيلاً بعد جيل، كما كتبتُ عن الأسر التي صارت مجموعة صور أو حفنة ذكريات وحسب، حاولت أن أنتقل من حالة توصيف الحزن والبكاء إلى حالة توظيف هذا الحزن والبكاء من أجل التغيير وتفعيل الواقع.
ومن عجب أنني كتبتُ باندفاع وحماسة في زمن أفولهما.
كنتُ أكتب دون أن أدري من سيكون الناشر لأعمالي، لم أحسب حساباً لكل الخراب الذي حدث في (م.ت.ف)؛ تلك المنظمة التي أوجدت دور النشر، وحركة الترجمة، والإعلامَ في السبعينات، والتي انطفأت بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني انطفاءً مؤلماً وموجعاً؛ انطفأت مع ولادة جيلنا الأدبي في مستهل الثمانينات؛ جيلنا الذي أبصر معظم الأغلاط الفاقعة التي وقع فيها الجيل السابق عليه أدبياً أيضاً، لأن كتّاب الستينات والسبعينات كانوا بمثابة المنارة والأضحيات لنا لكي نوجد مسافة مابين النص الأدبي والحماسة للثورة، ومابين الأدب الإبداعي والقول المتناثر في الهواء، ومابين البيان والقصة، ومابين الانتصار وما يقال عنه، ومابين النص الأدبي واللوحة...الخ، ولولا هذا الجيل لما تعلّم أبناء جيلنا أشياء كثيرة جداً، ولما تفادوا الوقوع في الكثير من العثرات والمطبات التي شوّهت بعض التجارب الأدبية في الستينيات والسبعينات، ومع كل ذلك كانت تلك التجارب هي الملعب الذي ركضنا فيه لكي ننضج أدبياً وإبداعياً وفكرياً.
لقد تعلمت من القصص الفلسطينية المكتوبة داخل الوطن المحتل تفصيلات الأمكنة وحميميتها، إذ لم تكن تعنيني الفكرة؛ أو الهدف، أو طريقة الكتابة قدر ماكانت تعنيني تلك التفصيلات التي توصّف الأمكنة وتسمّيها، كنت على عطش لأسمع أسماء الحارات والأزقة؛ ولأقرأ أسماء الشوارع والكنائس والجوامع في المدن الكبيرة مثل القدس وحيفا ويافا وعكا وغزة، ولأعرف مواقع التلال و الجبال والأنهار والمُغر، وأسماء النباتات والأشجار، والدروب. أما القصة الفلسطينية المكتوبة في المنفى فقد تعلمت منها كيفية تناول الموضوعات الكبيرة، وتأطير الأسى والحزن، وما يفكر به الفدائي وهو في قاعدته الفدائية أو وهو في ذهابه نحو الوطن المحتل في إحدى العمليات، تعلمت أسرار العلاقة العاطفية التي جمعت الفدائي بالأمكنة، التي حمته لائذاً بها عن أعين الصهاينة نهاراً، وحرسته ليلاً وهو ناشط في عمله المقاوم، والدروب التي أخذته إلى أهدافه، والدروب التي عادت به سالماً إلى القاعدة أو الأسرة، كما تعلمت الروح الاجتماعية التي ربطت الفدائي والمجتمع العربي إلى قضية واحدة، وتوجه واحد؛ ثم كيف صار الفدائي قلادة العرب وبيرقهم في أعقاب هزيمة عام (1967).
تلك القصص الفلسطينية المكتوبة في داخل الوطن الفلسطيني المحتل، وفي خارجه هي التي أوجدت مع الشعر الفلسطيني أدب المقاومة الفلسطينية الذي سيظلَّ ركناً مهمّاً من أركان الأدب العربي المكتوب في النصف الثاني من القرن العشرين.
ـ 5 ـ
أما الرواية، فقد كتبتها تحت ضغط تفهم لأمور ثلاثة، الأول: هو همّ الحفاظ على الذاكرة الشعبية، وكتابة المشفوه الفلسطيني، وهو مشفوه على درجة كبيرة من الأهمية، خصوصاً ما يتعلق منه بالأمكنة، والأحداث والتواريخ. وكان فزعي الأكبر يتمثل في تناقص حملة هذا التراث ومورّثيه، فقد بدأ المتقدمون في السن يلوحون للحياة قهراً، وتباعاً واحداً بعد الآخر، وقد كانت الأخبار والمرويات التي يقصها هؤلاء الناس عن الأرض، والقرى والمدن، والأحداث، والمواقع، والأعلام، والتراث... هي التاريخ الذي رمّم الكثير من الثغرات الموجودة في التاريخ الفلسطيني المكتوب والمتعارف عليه. كما أنها كانت، في أكثر الحالات والأحيان، مرويات مصححة لذلك التاريخ لأنها مرويات موثّقة ومدعَّمة بالآراء المتطابقة أو المتشابهة حول الحادثة الواحدة أو الشخصية التاريخية المحددة.
ثانياً: الخوف على المستقبل، وانفتاح التراجيديا الفلسطينية على أوسع أبوابها من حيث الأمل والطموح من جهة، ومن حيث الأسى والأحزان والخراب في وقت واحد من جهة ثانية؛ ذلك لأن هاجس تجسيد الأمل والطموحات رافقه خرابٌ مرعب ومفاجئ ومبكر في التصرف والسلوك في أكثر الأحيان، وبسبب من هذا التوجه نحو تجسيد الأمل والطموحات تمَّ التغاضي عن الكثير من الأغلاط والأخطاء، لكن عندما صارت تلك الأخطاء والعثرات تشغل مساحة كبيرة من حيز العمل الفلسطيني نهض الخوف الاجتماعي والفكري على الحاضر والمستقبل في آن معاً.
وثالثاً: لقناعتي بأن الرواية، في أيامنا الراهنة، تشكل المضاد الحيوي الناجع للهاث النفس وتعب الروح في زمن متسارع اخترمته المادية الربوية بفظاعة عجيبة، فالرواية هي التي تولّد التأمل والتفكير وهي التي تستدعيهما، وهي التي تنسق الأحداث وتحقبها في حقول واسعة تضم خبرات حياتية متعددة الوجوه والاتجاهات، وهذا ما تحتاج إليه النفس في حمّى فورانها وانشغالها العجولين. لهذه الأمور الثلاثة كتبتُ الرواية لإحساسي العميق بأن القصة لا تستطيع النهوض بأعباء أحداث وفواجع، وآمال كبيرة كما تنهض بها الرواية. و أعترف بأنني لم أنشغل بعالم الرواية لأن الأحاديث الطيبة تتعدد وتتكاثر حولها في الآونة الأخيرة لقناعتي بأن القصة الناجحة، كما القصيدة الناجحة، ما زال لكل منهما الدور والحضور والمتلقي الشغوف.
كتبتُ، إلى يومنا الراهن هذا، ثلاث روايات لكل منها ظروفها وأسبابها ومصادفاتها الأكيدة. في الرواية الأولى طاردت المرويات الشعبية للقبض عليها ووضعها في سياق تاريخي محدد هو زمن ما قبل الرحيل من فلسطين، وفي الرواية الثانية حاولت أن أكتشف الفلزات الإنسانية القريبة مني، والتي لم أدرك معانيها ودلالاتها وهي في متناول يدي. وفي الرواية الثالثة عدت إلى عالم الأسطورة والميثولوجيا واستندت إليهما من أجل فهم الحاضر واستيعاب ما يدور فيه وما يحدث.
الرواية الأولى كانت رواية [السواد] التي اعتمدت فيها على المشفوه الشعبي الفلسطيني، كما اعتمدت على المرويات الفلسطينية المتناقلة شفاهاً بين أبناء الريف الفلسطيني، وعلاقة الريف بالمدن الفلسطينية المجاورة من جهة، وبالمستوطنات الصهيونية المجاورة له أيضاً من جهة ثانية. قاطعت بين هذه المرويات، وسجلت ماهو مشترك بين الناس حول حدث بعينه، أو شخصية بعينها، أو زمن مضى ما يزال يؤثر في الحياة العامة. وبعد ذلك وقفت على الدور الذي لعبه المواطن الفلسطيني البسيط الذي يعمل في تربية المواشي والزراعة تحديداً في أحداث الثورة الفلسطينية قبل عام (1948)، ومابعد هذا التاريخ بقليل، أي إلى عام (1956)، حين حدث العدوان الثلاثي على مصر، و ما تركه هذا العدوان من آثار كبيرة في الحياة الفلسطينية ولاسيما أن الإسرائيليين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة نتيجة انتصار شعب مصر بقيادة عبد الناصر على قوات هذا العدوان، والموجة القومية الكبيرة التي اجتاحت نفوس أبناء العروبة جميعاً، ومنهم أبناء الجليل الفلسطيني، وقطاع غزة الذين دفعوا الثمن غالياً بسبب تأييدهم لعبد الناصر وبسبب استماعهم إلى إذاعة صوت العرب تحديداً. وقد كان الفضاء المكاني لروايتي الأولى (السواد) هو منطقة الجليل على طول نهر الأردن، أي ذلك الشريط الريفي الغني الذي يمتدّ من قرية الخالصة في الغرب، والتي تسمّى اليوم (كريات شمونة)، وصولاً إلى قرية (الزنغرية) المحاذية لبحيرة طبريا في الجنوب.
أتعبتني رواية (السواد) لأنني احتجت إلى الوقت الطويل لكتابتها ذلك لأنني عنيت بتقاطع المعلومات والمرويات للوصول إلى الحقيقة والواقع.
وقد حفلت تلك الرواية بكم كبير من الحنين والاحتفائية بالأرض والماشية وتماهي العلاقة الإنسانية مع الأرض والحيوان حيث كانا (الأرض والحيوان) أعزَّ مايملك الإنسان الريفي، كما احتفت الرواية بتسجيل التراث الفلسطيني من خلال تجسيد مجريات الحياة العامة وتأثرها الكبير بالغزوة الصهيونية، وشراسة اليهود ضد الفلسطينيين، خصوصاً بعد عام (1948)، تلك الشراسة التي صارت مركّبة ومعقدة أكثر بعدما امتلك اليهود الأسلحة والأرض ومقاليد الأمور [تذكر أمي، وقد كانت صغيرة، أن جدتي، لأبي، كانت ترفض أن تعلم امرأة يهودية تسكن إلى جوارنا، جاءت من اليمن، كيف تطبخ بعض الأكلات الفلسطينية، وأن تلك المرأة اليهودية كانت تبكي من أجل أن تتعلم كيفية الطبخ، وأن جدتي تعنفها وتصدها، وتقول لها إن هذه الأكلات فلسطينية حتى وإن تعلمت طبخها، فهي لن تكون بطيابة الطبخ الفلسطيني، وستظل فلسطينية، ولن تصير يهودية أبداً. وتقول أمي إن تلك المرأة اليهودية نفسها، وبعد احتلال اليهود لمعظم الأرض الفلسطينية سنة (1948)، ارتفع صوتها على جدتي، أو لنقل "قويت عينها"، وصارت تتأمر على جدتي من أجل أن تطبخ لها بعض أنواع الطعام الفلسطيني بيديها بعد أن كانت، من قبل، ترجو وتبكي لكي تحوز على بعض الإرشادات الأولى التي تمكّنها من الطبخ].
في هذه الرواية "السواد" وقفت على بعض أشكال المقاومة الفلسطينية ضد اليهود الذين باشروا ببناء المستوطنات الجديدة والمتعددة. سجلت مشهديات مقاومة الفلاحين والرعيان ومواجهاتهم للصهاينة من جهة، وشراسة الصهاينة وصلافتهم وعدوانيتهم تجاه الأرض والإنسان من أجل حيازة الأرض واقتلاع الإنسان من جهة ثانية. لقد أوذي الإنسان والحيوان كما أوذيت الأرض، ولهذا كانت جبهة المقاومة متعددة الأطراف ودائمة أيضاً.
في الرواية الثانية (تعالي نطيّر أوراق الخريف) حبّرت خوفي على الورق. وقلت إن يدي على قلبي لأن (م.ت.ف) في خطر مبعثه ا لقادة الجدد، (القادة المنبريون)، الذين استلبوا إعلامياً وبهرجةً، ومظاهر خادعة، هؤلاء الذين ارتضوا بالظاهر الهش على حساب المتواري الفاعل والجوهري. قلت: انتبهوا إننا في خطر، وقد أصبحت المكاتب أهم من الخنادق، والفنادق أهم من القواعد الفدائية، والعلنية أهم من السرانية، والجريدة أهم من البندقية ... انتبهوا!!
حاولت أن أعيد للفوتيك الفلسطيني معانيه الأولى، ولطقوس المقابر عزّتها الأولى، ورعشات القلوب الأولى، والمشهديات الحزينة الأولى. قلت انتبهوا لقيمة الشهادة، لدورها، لروحها، لمجدها، لمعانيها حيث كان يلتقي المخيّم الفلسطيني بصغاره وكباره، ورجاله ونسائه، وغنيه وفقيره، يلتقي على الشهيد في درب واحد، هو درب الشهادة الذي كان يأخذ الناس من بيوتهم وأعمالهم، والطلاب من مدارسهم، والعشاق من عشيقاتهم،.. إلى حيث هي المقبرة التي صارت أوسع مساحة من بيوت المخيّم جميعاً، وأكرم من بيوته جميعاً، فقد غدت المقبرة الفلسطينية مشيمة اقتصادية لأسر عديدة في المخيم، ذلك لأن زحف الآلاف وراء الجنازات أو ملاقاتها استوجب وجود البائعين على طرفي الطريق الموصل إلى المقبرة، الطريق الأوسع والأعرض في المخيم؛ وجد بائعو المرطبات، والسندويش، والحلويات، والأحذية، والأقمشة، والخضار والفواكه... لأن الناس كانوا ينتظرون ساعات وساعات حتى تأتي جنازات الشهداء، فتقوم الأمهات بإعداد طبخاتهن في الطريق، ويأكل الأطفال اللحوحون من عربات البائعين في مشاهد بالغة الدهشة والحزن حيث تلتقي الحياة بالموت، وحين انمحى الدرب إلى المقبرة انفض البائعون بعدما انفض الناس،وظلت المقبرة وحيدة وقد انقطع سيل الجنازات إليها، وبذلك نشفت المشيمة الاقتصادية واختفت، وتحولت المقبرة الفلسطينية إلى مقبرة حقيقية، إلى مقبرة فقط!!
رواية (تعالي نطير أوراق الخريف)، كانت صرخة حادة بحجم جزء من الخراب الذي حرف التوجهات النبيلة؛ الخراب الذي قلّل الاحترام للبندقية والفدائي معاً، قلت في هذه الرواية: انتبهوا، لقد استفحل أمر الاستهلاكية، وأن النخر صار عميقاً في الجسد الفلسطيني وجسد الثورة، انتبهوا لأن الربا؛ وحب الشهوات الدنيوية صار الهاجس والغاية.
في (تعالي نطير أوراق الخريف)، مدونة لحياة الفلسطينيين في المنفى، في أحد مخيمات دمشق، هو مخيّم جرمانا؛ حياتهم وهم يعشقون ويفرحون بين خبرموت وخبرخيبة، وبين موسم للبرد وآخر للعطش. ومن عجب أنني وجدت أن كثيراً من القواسم المشتركة الدالة، والمتشابهات العديدة موجودة بين جميع المخيمات الفلسطينية الموزَّعة داخل الوطن المحتل وخارجه؛ فهي جميعها ذات مناخ طقسي طارئ، تقف إلى جوار الطرق، في الأطراف البعيدة، (كدت أقول: الأطراف المنبوذة) وكأنها متأهبة للسفر والرحيل إلى العودة المنتظرة. قدمت الأرواح الحائرة التي ظلمها الماضي، والتي كواها الراهن وما يزل، هذه الأرواح النافرة رغماً عنها، إلى ظلم المستقبل أيضاً، وبيّنت مفاعيل القلق الفلسطيني الذي راح يفتك في كل الكائنات الحية المكانية والزمانية والبشرية؛ حتى نباتات النعناع والحبق لا تعيش في المخيم سوى أيام فقط، نباتات لا تعيش موسماً كاملاً، بل إن (نعوم) إحدى نساء المخيم المتقدمات في العمر، والتي لم تعرف الزواج يوماً، حاولت أن تستبدل بأولادها الذين لم يأتوا بعض طيور الدجاج. فما عاش الدجاج لديها على الرغم من عنايتها المفرطة به، وقد كانت ، مع كل صباح، تبكي بحرقة موجعة، حين تجد دجاجاتها ميتات في القن، تبكي وتنوح فتلومها الجارات بقسوة وغضب، وحين تضبط دموعها تقول: لماذا اللوم، المفارقة صعبة! عندئذٍ تفرُّ الجارات من أمامها أسى وحزناً وقد تذكرن أولادهن ورحيلهم المُرّ. فقد عانيت الكثير الكثير من أجل نشر هذه الرواية. وقد أرسلتها إلى جهات ناشرة عديدة، ولكنها جميعاً رفضتها لأنها انتقادية، وجريئة، وتسبب مشاكل عويصة، لقد قرأها أدباء، ونقاد، وناشرون يعملون في جهات ثقافية عديدة ورفضوا نشرها لأنهم رأوا فيها انتقاداً جارحاً لشخصية ما، توهموا أنها تخصّ رجلاً متنفذاً في الوسط الفلسطيني له علاقة مباشرة بالجهة الناشرة التي تزمع نشر الرواية، مثل تلك التشخيصات، ونسبِ الشخصية المنتقدة في الرواية إلى فصيل فلسطيني بعينه، أو إلى تنظيم فلسطيني معروف حالاً معاً دون نشر الرواية، وقد كانت تعود إليَّ مشفوعة بالاعتذار والإشارة إلى التشخيص العيني الذي حال دون طباعتها.
ولم تنشر الرواية أو يلتفت إليها إلا عندما فازت بجائزة الرواية العربية للشباب في مدينة القاهرة بمصر سنة (1990)، ومع أنها فازت، وقد تكفلت الجهة مانحة الفوز بطباعتها؛ إلا أنها لم تطبع تحت ذرائع شتى منها: عدم توفر الورق، ثم عدم توفر التمويل، ثم سحب التمويل نهائياً بعدما ذاع خبر سرقة الأموال من قبل القيمين على شؤون الجائزة.
ولم تطبع الرواية إلا في أوائل عام (1994) ضمن منشورات اتحاد الكتاب العرب، وبعد مجزرة حقيقية من التشريح والرفض والخوف والتردد...
أما الرواية الثالثة(جسر بنات يعقوب) فقد كانت تجربة مضنية، أخذت من عمري سنوات عديدة، قضيتها في البحث عن أجوبة لأسئلة لها علاقة بالميثولوجيا، والتاريخ، والواقع؛ أسئلة كان في طالعها سؤال طفلي بسيط فحواه، هو لماذا سمي (جسر بنات يعقوب) الواقع على نهر الأردن (نهر الشريعة) بهذا الاسم؟! وقاربت السؤال فقلت لابدَّ أن أهمية ما حاز عليها هذا (اليعقوب) حتى سمي الجسر باسمه، فهل كان هو بانيه؟ وإن كان كذلك فلماذا لم يسمِّ الجسر بـ(جسر يعقوب)؟! وهل المقصود بيعقوب هنا.. النبي يعقوب نفسه؟! وإذا كانت الإجابة: نعم، فهل كان للنبي يعقوب بنات عديدات؟! وإذا لم يكن يعقوب هذا هو النبي يعقوب، فمن يكون إذاً؟! أسئلة كثيرة عايشتها سنوات عدة، وشاركني قلقها من بحثت عندهم عن الإجابات، استشرت المعاجم التاريخية والدينية، وبحثت فيها عن الكلمات الثلاث: (الجسر)، و(البنات)، و(يعقوب)، فوجدت أن الجسور عديدة، والبنات المشهورات كثيرات جداً، واليعاقبة في تعاقب وتكاثر على مرّ العصور. وبعد كلّ هذا البحث لم أصل إلى أصل التسمية، وكان بحثي في الأساس يدور من أجل أن أعرف سبب التسمية لأن أرضنا في فلسطين ممتدة إلى جوار (جسر بنات يعقوب). وحين أخفقت في العثور على إجابة شافية خطرت ببالي فكرة الرواية، قلت لنفسي لماذا لا أكتبُ رواية تجيب عن هذا السؤال؛ أي لماذا سمي هذا الجسر التاريخي بـ(جسر بنات يعقوب)، وفعلاً كانت الرواية بعد ثماني سنوات من السؤال والكتابة معاً.
وقد جعلتها تدور على حوامل معرفية عدة كالدين، والميثولوجيا، والأسطورة في مناخ تلعب فيه طيوف الأنثى الدور الأبرز والأهم باعتبار الأنثى مغوية من جهة، ومنقذة للعالم من جهة أخرى، وقد حققت الرواية الطرف الأول من المعادلة (الإغواء)، وأخفقت في الطرف الثاني لأن جمال الأنثى في الرواية لم يكن مورّثاً بعدما قايض الجمال طيوفه ومشهدياته بالمال فأصابه الذبول والانطفاء.
في الرواية ثلاث كتل اجتماعية أساسية، الكتلة الأولى: يمثلها الدير والراهبات، والثانية: يمثلها يعقوب وبناته والخان القريب من الجسر، والثالثة: القرية وأهلها، والعلاقات التي تربطهم بالدير والخان في آن معاً...
وفي الرواية ثلاثة أمكنة أساسية، الأول: هو العالم العلوي ويمثله الدير بما فيه باعتباره المكان الأقرب إلى السماء وروحها.
والثاني: العالم الواقعي، ويمثله الخان بما فيه باعتباره المكان الأقرب إلى المادية وشهوة الاستحواذ، حيث يفرض يعقوب ضريبة على كل عابر للجسر سواء أكان العابر إنساناً أم حيواناً، أم شيئاً يخصّ أحدهما أو كلاهما معاً، وحيث تقوم بناته بتصيد الرجال باعتبارهن بؤرة للحلم المشتهى.. والعالم الثالث: هو العالم السفلي، عالم الليل والعتمة والعزلة ومواجهة الذات، هذا العالم المشدود إلى العالمين العلوي أولاً باعتباره متطلباً للروح ودوافعها وتوقها إلى الطهرانية، وهو عالم سراني، وثانياً العالم النهاري باعتباره عالماً يقضي شؤون الحياة وعبر منطلق متوارٍ، أو سراني، ولكن سرانية العالم أضحوكة أو كذبة ليس إلاَّ.
وفي الرواية ثلاثة أديان سماوية تتقابل، وتتماهى؛ تتنافر وتتباعد بين حين وآخر من دون أن يطوي أحدها الآخر، ومن دون أن ينطوي أحدها ضمن الآخر.
وفي الرواية ثلاث كتل أنثوية، الأولى: مكونة من ثلاث بنات راهبات يمثلن عالم الدير، يتنكرن بزي الرجال خوفاً وتحسباً من الطامعين بالمتع الأنثوية، ثلاث بنات عذبتهن نزواتُ الحياة فشددن الأعناق نحو السماء طلباً للخلاص، والكتلة الثانية: مكوّنة من لثلاث بنات، هن بنات يعقوب، ويمثلن عالم الخان، وهن يمتلكن أسرار الجمال والغواية ومظاهر اللطف الأنثوي، يوظفن كل هذا من أجل الوصول إلى غاية و احدة هي الاستحواذ على المال. ولكن حين يصلن إلى المبتغى المأمول يخسرن الجمال، وأولادهن الذين دفنوا أجنةً في مقبرة تحتفي بطقوس الدفن ليلاً، لأن حالات الإجهاض كانت تتم سرَّاً وبعيداً عن نظر الأب باعتباره ممثلاً للأنا العليا؛ طقوس دفن لا يشارك فيها سوى البنات الثلاث أنفسهن. والكتلة الثالثة: مكونة من امرأة عجوز نصفها واقعي، ونصفها الآخر وهمي متخيل، لا تبدو إلا في الأوقات العصيبة شأنها في ذلك شأن الآلهة في الأساطير اليونانية فهي لا تنزل إلا من أجل حلّ نزاع ما، أو مشكلة استعصت على بني البشر، امرأة لها علاقة بالأعراف الاجتماعية، والتعاليم الدينية، ذات مهابة وحضور طاغيين، لا تتحدث إلا بمقدار، لها سطوة محتجبة بين سطور الرواية وأحداثها، حيث إن القارئ يخامره الإحساس وكلما ضاقت الأمور أو احتبكت بأنها ستظهر بين لحظة أو أخرى، وقد عملت هذه المرأة كنصيرة دائمة ليعقوب وبناته، ولم تتوارَ إلاَّ عندما مات يعقوب مقتولاً.
وعدا عن هذا، فالرواية تحتفي ببكورية الطبيعة، وأسرار الماء، حيث لا ناظم لجميع هذه الكتل، وذلك التاريخ سوى ذلك الشريط المائي الذي اسمه نهر الأردن (نهر الشريعة)، وما ينتجه الماء من ظلال وخضرة، ومساءات رائعة، وما تستحضره تلك الظلال والخضرة والمساءات من أحاديث وأوقات، وجمال، ورهافة أنثوية محلومة.
ـ 6 ـ
وبعد،
فإنني لم أقدم طرفاً من طفولتي وأيام شبابي، والظروف الصعبة التي عشتها مع أسرتي من أجل أن أحوز على تعاطف مجاني... إطلاقاً، وإنما قدمت ذلك لماله من وشيج العلاقة بالكتابة، لأنها تشكل مصدراً من مصادر تعلمي واستفاداتي، ومرجعاً من مراجعي التي أعود إليها لأضبط خطواتي، كما أنني لم أقدم بعضاً مما تعلمته عن فن القصة والرواية، وعن أسلوبي في الكتابة، وعن بعض ما جاء في رواياتي من أجل أن أستعرض ثقافتي.. أبداً، لقناعتي بأن ثقافتي قليلة، وأن خبرتي غير جديرة بالحديث عنها، وأنني لم أمسك بعد بطرف الخيط الإبداعي الذي أحلم به يومياً. لقد قلت حديثي السابق من أجل أمرين اثنين هما: الوقوف مع المتلقي على أرضية مشتركة لفهم الدوافع والغايات والأسئلة وحالات اللوبان قبل الكتابة، وفي أثنائها، وبعدها، ثم لكي تتماهى روح الكاتب وروح المتلقي في مناخ إنساني واحد مرغوب..
حسن حميد