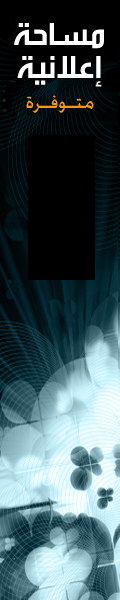حسن حميد*
إلى العزيزة الغالية
سميرة العايش
-1-
يا إلهي،
من كان يدري أن ما حدث كان سيحدث، وأن رنّة الحزن ستمتدّ وتستطيل مثل وهج النهار.
من كان يدري أن البنت جورية، زينة الحي، الطويلة الملأى ذات الغمازة العميقة الضاحكة.. ستدير ظهرها لعبودة الذي منّى العمر كله أن يأخذها بين ذراعيه في ضمّة حانية لهوف، ثم.. فليأت الطوفان.
أبداً، ما من أحد، من أبناء الحي، كان يشكّ بأن جورية الرهيفة قد تعبت كثيراً مع أمها العجوز التي تورّمت ساقاها، فعجزت عن الحركة، وعادت مثل طفل صغير، تنظرُ بعينيها فقط، وتهمهم وتناغي من دون كلام.
لقد أقعدها المرض، فباتت تقضي شؤونها كلها في فرشتها الملونة التي شرعت بين حين وآخر، تطلق روائح لا تحبها جورية، تلك الروائح التي لا تشمها أمها أبداً، لكأنها صارت جزءاً منها أو جزءاً من المكان.
(كانت جورية، وفي غبشة الصباح، تفتح النافذة الوحيدة، وتنظف جسد أمها بعناية شديدة، تمسحه بالماء الدافىء والصابون، وتدلك ساقيها بزيت الزيتون الصافي، ثم تكنس أطراف الفراش، وتسحب الأوساخ، وترش هواء الغرفة بالكالونيا. وحين يغدو كل شيء في تمامه، تغادر الغرفة، ونظرُ أمها عالق عليها يطردها بالرضا والامتنان. تغسل يديها ثم تهيء طعام الإفطار لها ولأمها وسط حديث وحيد، وتمتمات حزينة، وضحكات صغيرة مرتبكة، ورجاءات طويلة بأن يمنّ الله عليها بالشفاء لتملأ بيتها بالحركة والأحاديث، والضحكات الصاخبة، لكن الرجاءات ظلّت رجاءات، والأماني يبست على الأماني).
-2-
منذ سنين بعيدة، جاءت جورية إلى الحي مع أمها، طفلة في الثامنة من عمرها، وردة أو تكاد. سكنت مع أمها غرفة صغيرة فوق السطوح مثل طيور الحمام، وبأجر زهيد.. كانت الأم تدفعه لـ"أبو راجي" صاحب البيت في نهاية كل شهر، بعدما عاشت وجورية، في أحياء وبيوت عديدة، على طيف من القلق والمخاوف من زوجها الذي طاردهما طويلاً.
كانت الأم تنتقي البيوت الظليلة المتوارية، وترحل من مكان إلى آخر. وكانت كلما ازدادت طمأنينتها مع الناس، تمحو المكان. لكنها، ومع الأيام، امتدّت نحو أهالي الحي فعاشرتهم حتى صارت منهم، وتربّت جورية مع الصبيان والبنات، فكوّنت لها معهم عداوات وصداقات.؟
وما من أحد، في الحي، عرف سر الأم وابنتها سوى عبودة الذي لهف قلبه لـ جورية، فسعى إليها مرات ومرات، عبودة الذي سهر ليالي البرد الطويلة قرب نافذتها، وهي ممعنة في الصدود والعذاب. وحين عرفته رقّت له، وقد أسرها بلطفه، وطول صبره، فالتقيا.. شكت له مُرَّ أيامها، وأحزانها الولود، وشكا لها قسوتها، وجمرة الغياب. وحين تذوقها جنَّ بها، وطارت هي بحلاوة ريقه، وعذوبة حديثه، فضمته إليها ضمةً أغلقت عليه باب محبتها حتى لقد صارت دنياه وسعادته الضافية.
(كانا، وحالما يباغتُ أحدهما الآخر في النهار، يسترقان النظر، فيبتسمان، وتنادي الروح روحها، وتواعدها عند حلول المساء، وعندئذٍ، يهفو عبودة إليها حذراً، هامس الخُطا، مورّداً كالأرجوان.
فتلقاه هي ريانة دائخة كأنها في منام، ويهبطان فوق السطوح، قرب البراميل في مفرش طيِّ الدفء والهمهمات التي تجمّر الكلام.
كان عبودة، وحين يسبقها دائماً إلى مكانهما تحت السماء الفسيحة المنجّمة، ينصت عميقاً ليسمع وقع قديمها كمن ينصت لعزف كمنجات ضاقت عليها أوتارها بالحنين.
وقربه، ترمي أحزانها البعيدة، فيحسُّ عبودة وكأنها، وهي في هدأتها وطمأنينتها، مطاردةٌ من شيء ما، مذعورةٌ من وحش يكاد يلامسها، أو ينقضُ عليها، وهي نفور متأهبة لتنتفض هلوعةً بين لحظة وأخرى، فيهامسها، ويهزها كي لا تنفرد، ولو للحظة واحدة، بمخاوفها الدائمة. ويخبرها بأنه ما عاد يطيق صبراً، بعدما صار خوفها خوفه، فهو سيفاتح أمها في المساء القادم، بأنه يريدها.. ولو بالإشارة أو الهمهمة!!.
فتدور الدنيا بـ جورية وتغدو خفيفةً، شفيفة كالطيف، فتنشدُّ إليه بحنو لم يعرفه من قبل، ويقترب منها، فينطفىء الكلام، ولا يمضيان إلا بليلين بالندى قبل أن يفضحهما النهار).
وفي الصباح،
وكأن ما كان لم يكن، يتقابلان. تحكي له، ويحكي لها.. ثم تأخذهما الدروب إلى أن يحين وقت المساء.
(هذا الصباح، كانت جورية على عجل، فواقفته للحظات، ثم استدارت. رأى وجهها معتكراً، كأن النوم جافاها، أو لكأن أمها تودّ أن تبكر بالغياب فيدنو منها، ويسألها، وقد حثّت خطاها فتقول:
* "إنه منام"!!
وتلوّح له بيدها، وتمضي نافرة كأنها في طراد، فيناديها عبودة مذكّراً:
* "في المساء"
فتهز رأسها، وترمي له ابتسامتها البيضاء الوسيعة كي لا يظل حائراً وقت النهار. يرامقها، وقد ابتعدت، فيحسُّ بمخاوفها، وساعة المفاجأة التي لطالما حدثته طويلاً عنها، يتذكر الآن أنها قالت له بأن سرها أبوها، الذي صورته أمها لها رجلاً مرعباً كالغول، وهي التي لم تره منذ أمد بعيد، يوم كانت طفلة في الثالثة .
لكنها تشعر، وفي كل لحظة بأنه على مبعدة ذراع منها، وأنه سيأخذها متى يشاء وحين يشاء ويترك أمها لمصيرها وحيدة للقدر. فيحسها الآن وهي تتلاهث لكأن يداً ما تطبق على روحها، فيهدهدها، ويطمئنها بأن أباها لن يعرفها الآن بعدما نمت وزهت مثل حبق الدار، وأنه لن يلتقي أمها، وقد صارت قعيدة الفراش، فلتهدأ روحها ولتطمئن.. فهو قربها كالزمان.
غير أنها تظلُّ تردد جملتها المحزنة:
- "أنت لا تعرف أبي، يا عبودة، فهو سيد الأمكنة والسؤال".
وتغصُّ، فيستوضحها، لكنها لا تجيب.
تبدو له، وهي قربه، أنها في دنيا أخرى موحشة نائية. خائفة من المفاجأة التي ستجعل أمها وحيدة غريبة ترفو أحزانها بخيط دموعها، والتي ستجعله هو.. ندبةَ الأحلام).
-3-
وفي المساء.
جاءها عبودة على موعدها، ممنياً النفس بلقياها، وقد غابت كل النهار، حاول مراراً أن يراها فوق السطوح، أو قرب بوابة الدار، لكنها لم تظهر. كان مستنفراً لا يهدأ على حال.
دفع بوابة السطح بهدوء، فصرّت بأنين حزين لم يعهده، فانقبض قلبه وانتفض. وخطا إلى الأمام. كان ما بينه وبين الغرفة الصغيرة المنزوية في آخر السطوح، ممر طويل ضيق. تقدم، فتناهى إليه ضجيج خافت رتيب يتعالى من الغرفة، لكأن جورية تعد له مفاجأة للقاء. بدا مضطرباً لا يحس بالظلمة التي ظلّلت الأشياء. تقوده قدماه نحو مكانهما المعهود. ولم يفطن لغياب هديل الحمام، وفزعه الحميم الذي اعتاده كل مساء. وفي مرقدهما هبط منتظراً قدوم جورية، ووقع قدميها فوق الخشب الحنون. انتظرها طويلاً ولم تأت. حتى لكأن طيور الحمام نامت مبكرة، وإلا فأين هديلها، وحيرتها اللجوج؟!! ابترد قليلاً وجورية لم تأت. انتظرها وقتاً آخر، ولم تأت. ظلت ممعنةً في الغياب. أخذته الحيرة، ولعبت به الظنون، وهاجمته المخاوف والهواجس، فنهض كالمقروص. ومضى حذراً نحو الغرفة كمن يمشي على أنفاسه. اقترب من الغرفة، بحث عن بابها وسط العتمة التي لا تفصح عن شيء، ولم يجده، دار حول الغرفة ولم يجد الباب أيضاً، أحسّ كأنه أضاع المكان. استدار ثانية، وجاء الغرفة من طرفها الآخر، فقابله الجدار، عاد فجاء إلى الغرفة من مدخلها الطويل الضيق، مقابلة لبابها لكنه لم يدفعه، أو يطرقه فقد صار في وسط الغرفة تماماً. هي ذي نافذتها مشرعة، تعبرها الريح الضاجة الرتيبة. لكن أين جورية وأين أمها الرقيدة، وأين الفراش؟! فما من أحد هنا. دار في المكان الصغير واستدار. حوّم طويلاً، لكن لا أحد. فالغرفة وحيدة بلا أنفاس. يكاد يهوي. يتقاوى قليلاً، فيستند إلى أحد الحيطان. يجول ببصره فيما حوله فلا يرى شيئاً ولا يسمع أنيناً أو لهاثاً. يحسُّ بأنه وحيد مع الريح العابرة. ويدور ثانية كمن يبحث عن الهواء. أبداً ما من أحد هنا، ما من شيء! ينحني على الأرض. يمسحها بيديه وبجسده، فيحسُّ ببرودتها بعدما اختفى بساط الخرق الملونة. يجفل عبودة، ويدرك أن المفاجأة وقعت، فالغرفة وحيدة تماماً. لكنه لا يصدق.
يشرع في المناداة، والهمهمة، ويمضي في البحث والدوران.
يتعالى زفيره، ويمتدُّ لهاثه، لكن دون جدوى، يوهم نفسه بأن جورية موجودة لكأنها عالقة به فيناديها، ويغمغم بالكلام، وما من أحد. وحين يهدّه التعب واللوبان يجلس خائراً، خائباً.. كأنها لحظات ما قبل البكاء. يخلع حذاءه ويمشي حافياً لعل قدميه تلامسان آثار الخطا التي مشتها جورية، ويلمس الحيطان بيديه، ويمر بأصابعه على الرفوف المذيلة بأوراق الجرائد المقصوصة يبحث عن صندوقها ليضمَّ عرائسها القماشية، وأمشاطها، وليقبّل مرآتها التي رأت وجهها طويلاً. ودَّ لو عثر على ثيابها المعلقة فوق المسامير لشمّها ثم لثمها.. ليمتلىء برائحتها. لكن لا شيء هنا. لا أحد سوى الحيطان.
يهبط الدرج إلى الأسفل، الأسفل، الأسفل. ينفلتُ في الأزقة والحارت. يمشي الدروب التي مشتها، لعله يصادفها آيبة إليه. يقضي الليل البارد العبوس باحثاً عنها في كل الأرجاء، وحين يطلع النهار يمضي مبكراً إلى البيوت التي عملت فيها ويسأل عنها. يواقف الناس ويسألهم، يناديها، كلما انفرد بنفسه، بملء الصوت لعلها تبدد كل هذا الجولان.
بدا، كمن ضيّع روحه، ناشطاً في البحث، والمطاردة، والسؤال، لكن دون جدوى، فعاد، وقد عاد المساء، وافاها على موعدها كأنه يجيء إليها للمرة الأولى. دفع البوابة، فصرّت بأنين كالبكاء، ومضى في الممر الطويل نحو غرفتها التي تصفر فيها الريح. بحث مرة أخرى، ونادى طويلاً. لكن ما من أحد. بدا المكان كالخراب. صعد الدرج الخشبي فشعر، لأول مرة، بأن صعوده لا يترك وراءه ذلك الرنين العذب.
صعد متراخياً لكأنه في جنازة. مضى.. فوق السطوح، نحو البراميل وأعشاش الحمام. وما من أحد. أحسّ بالبرودة تملأ قلبه. فنادى، وردّ الصدى جورية. ولا أحد، دار ولفَّ حتى خارت قواه، فارتمى، لكأنما الدنيا دارت به أو انعتمت عليه، وقد أيقن أن كل شيء انتهى، وأنه كان في حضرة السحر ليس إلا.رفع رأسه نحو السماء الفسيحة المُنجمة، فرأى من حوله طيور الوطاويط محوّمة في المكان، لها رهجة الفضة كلما استدار بها الجناح، فراح يراقبها، وهو يحسُّ، وقد هاجت الروح، بأنها.. طيور الحمام.