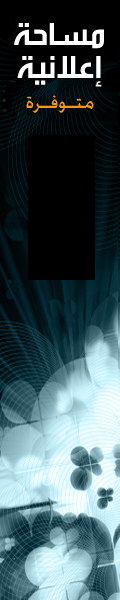بديعة
* إلى صديقي الرائع ياسين بلال
أبداً،
لم أرها من قبل ذابلة كلّ هذا الذبول.
حزينة، تدفع الخُطا، والابتسام دفعاً.
تدنو كأنها تؤوب، مطفأة، واهنة، يقودها إليَّ الممر الطويل الضيق المعتم، وأنا واقف خلف قضبان شباكي الصغير، في زنزانتي التي ألفتها وألفتني منذ سنين.
[كنت قد جئت إلى هنا بالضرب، والركل، والسُّباب، جئت زحفاً بعدما ورّموا جسدي وأنهكوه، وما كانت نجاتي.. إلا حين صرت خلف هذا الباب الحديدي الصدىء.
تواريت عنهم، وتواروا عني، وظللت وحيداً أتلهى بجروحي، وأفتش عن الأسباب التي حملتني إلى هنا.
في البداية لم أعثر على أي سبب؛ لكن مجريات التحقيق بيّنت أنهم حسبوني على جماعة عبدوش، وأنا بريء.. لا علاقة لي به. كان الرجل قد أعدّ قائمة بأسماء من هم في حكم الولاء له، وكان اسمي مع الأسماء. لكنني لم أرَ عبدوش إلا بالصور، ولم أعرف عن نياته شيئاً؛ كلُّ ما عرفته أنه أُخذ فجأة مع كثيرين، وكنت من بينهم. وقد أدركت تهمتي هذه بعد أسئلة عديدة، وبعد حفلات شرسة من الضرب المُدمي المُهين.
دائماً.. كانوا يسألون ببشاعة، وتندر، وقرف: عبدوش.. يا كلب؟ قولة واحدة راحت ترنّ في أذني كجرس الموت الأخير].
إنها تدنو مثل نهر دفوق، فتبتهج روحي وتصفق لهذا القبول الحميم. تقترب ببطء شديد كأنني أشدُّها إليّ بأنفاسي المتعبة. وحين تصل.. تواقفني مواجهة، لا يفصلها عني سوى صاج الحديد، أرمي لها كفيَّ من الشباك كأني أرمي لها نفسي؛ فتشابك أصابعها بأصابعي وتتنهد. أُمسّد على شعرها، وألمس وجهها بيباس أصابعي. أضغط على خديها، وقد انحنت على كفيَّ كصفصافةٍ.. ما أجملها!! أُوجعها، فلا تتألم. أفرش بصري على وجهها الشاحب المضاء بصُفرةٍ كابية، فأرى عينيها تترامشان بجفول، وشفتيها تتراجفان بارتباكهما الحيران. أهتف لها ببحة الصوت:
* "آخ.. تأخرت"!!
[كانت قد مضت سنوات كثيرة ولم ألمسها. كنت أراها من خلف الأسيجة كالضباب، وكانت تراني كالشبح، نتوحّد بالصوت للحظة أو للحظات.. ثم يأخذوني وتمضي].
ولا تجيب. تُفلت دمعها، فيتلامع وجهها ويشفُّ كالطيف. تبدو أجمل ألف مرة من شبّاك خشبي ناحل يحمل عشاً وفراخاً، وآنيةَ فخارٍ فيها حبقٌ كثير. تبدو ملجومة بصمتها ودمعها الحنون.
أهزّها، فتتساقط همهماتها خرساء بلا رنين. بصري يجول في وجهها حائراً مثل نحل طريد، يفتش فيه عن ملاذ صغير، أنسى نفسي قربها، وكفُّها حشو كفي، فأسمعها تقول:
* "لم أحب سواك"!
وتغصُّ، (أعرف ذلك) فأغصُّ، تبدو كمن يفتح جرحاً جديداً، ثم تضيف:
* "طلقني أرجوك.."!!
انتبه إليها للحظة، ثم تدور بي الأرض، فأهوي خلف بابي، كأنما أصابني طلق. أهجسُ.. تعرف أنها هي الدنيا الباقية؛ هي القليل الكثير، وتقول عند أول مواجهة:
* "طلقني " !! فما الذي حدث؟! ومن سيبقى لي سواها؟!
[كنتُ وحيداً، وكانت وحيدة.. غريبين في المدينة الكبيرة. التقينا في العمل مصادفة. عرفت أنها مقطوعة من شجرة، وعرفتْ أني وحيد تماماً في مدينة موحشة باردة. واتفقنا على الزواج. ورحنا مثل طيرين نؤثث غرفتنا الصغيرة التي استأجرناها في بيت العجوز أم شامان.. هنا مفرش الوليد، وهنا مكان الضيف، وهناك قرب شبّاكنا الوحيد سنشرب قهوة الصباح، وهنا بجوار العتبة سنزرع النعناع وعيدان القصب، (تمجد اسم الله كم أحبتِ النعناع)!! وحين تزوجنا، لم يأت الوليد، لم نعرف صخب الطفولة الرائع، ولا بهجتها النادرة، ولم نقطع الأمل. كنت أصبّرها وأنكسر لها، وكانت تساعدني على الأيام الحرون. لكن، وعندما اقتادوني فجأة إلى هنا.. قُطع كلُّ شيء؛ ولم يبق لي سواها، والآن تأتي، بعد كل هذا الغياب الطويل، لتقول لي:
* "طلقني"!! ]
وتعيدني إليها مرة أخرى، حين تناديني برهيف الصوت:
* "راجي"!!
أتقاوى على نفسي، فأقف خلف شبّاكي الصغير، أوازيها، أتساوى وإياها، نصيرُ مخلوقين راعشين دامعين، يهمهمان جاهدين فيخونهما الكلام، والحارس السمين قربنا ناشط في مراقبتنا، يحصي علينا أنفاسنا. أنظر إليها. أغيب في وجهها الألوف الذي أعرفه منذ ألف عام، وتغيب هي في حزنها العميم. ثم تقول:
* "اسمعني يا راجي!
ماعاد بيني وبين وقوعي الأخير
سوف كفٍ واحدة"!
وترامقني بعينيها البليلتين، لكأنها تودعني، أو لكأنها تؤبّنني، وتشرق بدمعها، وتضطرب؛ ودون أن أعرف أو أسمع شيئاً آخر، أو أن أقول أية كلمة، تدير لي ظهرها، وتمضي، فأحسُّ كأنها أمي تضيع في العتمة المديدة، أناديها ملتاعاً:
* "كفٌّ واحدة.. فقط"؟!
فلا تجيب. تمضي كرعشة الحلم، مرتبكة، مبللة بأحزانها، فلا تلتفتُ أو تستدير. وأهوي في مرقدي خلف باب الحديد طيّ حيرتي وقلقي راجياً الله أن أنام، أو أن أغيب عن الوعي كي لا أحترق أكثر بمشهد الإياب الأخير، وتطردني الأفكار وأطردها في الحيرة الوارفة. أشعر كأن الأشياء؛ كلّ الأشياء تنأى وتؤوب. ولم أدرِ إن كنت قد نمت أو أن الغيبوبة أخذتني، أو أنني سهوت؛ ما أدريه حقاً أنني وجدت قربي مغلفاً مليئاً بالأوراق!! من جاء به، وكيف وصل إليَّ؟! لا أدري. أحار به للحظات فقط، أقلّبه بين يديَّ، ثم أفتحه باللهفة الراجفة. أشمُّ رائحة بديعة. أعرف أوراقها. أراها بين السطور راكضة كاليمام. يا إلهي، إنه خطُّها (منذ متى لم أره؟!)، وهي ذي (حبيبي، نعناعي الجميل).. كلماتُها. أدفن بصري فيها، وأقرأ:
* "تعال لكي نبكي مرة أخرى.. معاً!
بعدما بكينا كثيراً.. أنت في وحدتك، وأنا في وحدتي، أنت الذي معي في كلّ شيء كأنفاسي، أنت الأقرب إلى قلبي من أصابع يدي. ثق، مهما حاولت، لن أستطيع إخراجك من روحي، فقد عشتك طيفاً كلّ تلك السنين الماضية، ولم تغب. لم أقوّ على الكلام من قبل.. كنت صامتة، محتاجة إلى كل هذا الوقت للوصول إليك.
أعترف بأنني بتُّ بعدك مثل الدائخة الشرود، لا شهية لي ولا روح، وباتت الحياة خراباً بلا رونق بلا بريق. وراودني الخاطر مراتٍ أن أطوي صفحة الأحزان، وأبدأ من جديد، ولم أستطع!! طيّرت كل كلام صديقاتي بأن أنساك؛ وكيف لي؟!.. فصورك الموزّعة في كل أنحاء غرفتنا الصغيرة، وثيابك، أحذيتك، وفرشاة أسنانك، صوتك الذي يرنُّ، أنفاسك التي تشيع، كنزتك الصوفية التي لم تكتمل (لم أعرف أين سأضع خطي اللون الكحلي)، كتبك.. كلُّها كانت حواجز جميلة تفصلني عن الآخرين وتبعدني. كانت رهافتك الآسرة سياجي وأنا أضرب هنا وهناك بحثاً عنك!!
لكن ما حدث رويداً رويداً مع مأمور سجنك خلال السنوات الماضية، ما كان بإرادتي أبداً!! فقد زلزلني ما حدث، وتعذبت كثيراً.. من أجلك! صدقني، على الرغم من كل وسامته الرَّاعبة، لم يلفت انتباهي، كان في نظري سجّاناً ليس إلا، واحداً من كثيرين عرفتهم من أجل الوصول إليك!!
للوهلة الأولى فوجئت بوجوده في حقل الأحزان الذي يضمّك، كان أخّاذاً بأناقته، ولطافته، وجماله؛ بل كان ناعماً كالخيال. أحسستُ بأنه رجل في المكان الغلط. وكدت أشهق من كل هذا الجمال الرجولي الحاضر في كائن واحد.
في البداية ماطلني كثيراً قبل أن يعترف لي بأنك موجود عنده. حوّم حولي كثيراً محاولاً الاحتكاك بي مثل دبور جائع طائش. وأدركت بحسي الأنثوي أنني رقتُ له من المرة الأولى. كانت نظراته العطشى قد أخترقتني بصمت، لذلك جئت إليه في المرات التالية وأنا في هيئات مزرية للغاية، لكن العجيب أن استلطافه لي كان يزيد كأنني أخفقت في التورية. سايرته مرة ودخنت سيجارة تحت إلحاحه المحيّر المربك (وأنت تعرف كم أكره التدخين) وشربت القهوة عنده مرات في الجلسة الواحدة (وأنت تعرفني لا أشربها إلا مرة واحدة في الصباح، اعذرني، إني أفصّل.. كي تفهمني تماماً)!!.
وأعطاني العديد من الصحف والمجلات؛ وفي إحدى المرات وجدت فيها رزمة من النقود الكثيرة، فأعدتها إليه، وارتبك، شعرت بتذمره الواضح، كأن المصيدة أخطأتني، لكنه شكرني (كاذباً بالطبع) على أمانتي. وأذكر أنه مدّ يده مرة نحو شعري ورفعه عن جبيني، فهاجت الروح، وذعر هو !! كنتَ معي، وقلبي يهتف اسمك "راجي ...راجي"!! لكن وحالما عدت إلى البيت، كان أوّل عمل قمت به أن قصصت شعري، فبدوت مثل صبي ذاهب إلى خدمة العلم. ومرة، حكّ إبهامه بظهر يدي، فكويتها. (ها أنت ترى إنني أعترف)، وفي مرة أخرى، تجرأ أكثر ولامس بإصبعه خدي وهو يثني على جمالي، فأحدثت فيه تلك الندبة السوداء. وواعدني مرة على اللقاء في أحد المطاعم الصغيرة التي لم أعرفها من قبل لأنه سيزفُّ لي خبراً مهمّاً عنك، فوافقته دونما تردد. كنت عطشى لسماع أي خبر عنك!! فذهبتُ إلى العنوان. وأنا أحسّ بأن كلّ الناس يعرفون موعدي هذا معه، كنتُ أظنُّ نفسي بأنني تلك العنزة البيضاء التي راحت تشقُّ عتمة جبل جلعاد!! (كان المطعم صغيراً، فخماً، وحميماً أيضاً). أكلت وشربت معه بكل الشهية التي فقدتها طوال السنوات البعيدة الماضية، بعدما قال لي بأنك موجود عنده (خمس سنوات مرت كأنها الزمن كله.. مرّت، وأنا أسأله عنك، فيقول لي إنني أبحثُ لك عنه. ويؤكد الآخرون بأنك عنده. كانوا صادقين، وكان كاذباً بالضبط)! وأخبرني بأنه لا يستطيع أن يتصرف إلا حسب ما تمليه عليه الأوامر. وعلى الرغم من كلَّ هذا فرحتُ فرحاً لا يصدق لأنك حيّ. أنت لم تمت. يا إلهي (أي خبر هذا؟!) ثمة شيء ما، لا أستطيع وصفه، بدأ ينمو في داخلي. أنت حيّ!! أحسُّ الآن أن الحياة تعود إليَّ مرة أخرى تركته، وهرعت نحو آخر طرف المطعم الصغير، إلى مقربة من الفتاة والشاب اللذين كانا يعزفان الموسيقى الجميلة الهادئة، وشرعت أرقص. لم تكن الموسيقى مناسبة، لكنني رقصت. ولكم حزنتُ لأنه هو من كان يصفق لي. كنتُ بحاجة لمن يرقص معي، فأخذت الشاب العازف.. ورقصت معه بجنون؛ وظلت صديقته تعزف لنا.. ولم أنتهِ من الرقص إلا عندما وقعت على الأرض. تقيأتُ كلّ ما شربتُ وأكلت، وغبتُ عن الوعي. ولم أعد إلى نفسي، إلا وأنا في بيته (ربما في أحد بيوته)!! كيف جئت؟ ومتى؟ ولماذا؟! لا أدري!!
المهمّ، أنني وجدت نفسي عارية أو أكاد، ليس عليّ سوى ثوب رقيق شفيف لا يستر شيئاً، وبقربي فتاة تلبس مريولها الأبيض. عرفت منها أنها ممرضة أحضرها للعناية بي في غيابه. وسألتني بسذاجة لماذا أنا عصبية لا أهدأ إلا بالحقن المنوّمة. وأنها تخاف عليّ، إذا ما أمضيت أسبوعاً آخر تحت تأثير المنوّم، أن أصاب بالاختلاطات المختلفة، وصرخت بها:
* "لي أسبوع هنا.."؟
فتمتمت بخوف واستغراب:
*"نعم مدام"!!
مدام!! تصوّر، يا راجي، أنا مدام. كم كانت تضحكنا هذه الكلمة، لأن فيها أنفاس الآخرين. وضبطت أعصابي، ورجوتها أن تنصرف، فأنا بخير، لست بحاجة إلى أيّ شيء، ولتأتِ في الغد. فوافقتني، هزّت رأسها، ومضتْ فعلاً. وبعدها. (حبيبي هل أرهقتك؟! ارمِ الأوراق جانباً، وأكملْ بعد حين. سامحني).
وحين هممت بالخروج، تفقدت جسدي، وصرخت.. كنت منهوبة!! أجل.. (لن أخبىء عنك شيئاً)، ولم يرتسم أمامي في تلك اللحظة سوى طيفك؟ كنت تنظر إليّ بأسى، وكنتُ ممرورة، وأخذني البكاء. أصبت بحالة من الذعر (أنا التي نذرت جسدي لك .. أنهبُ في غفلة من حواسي. يا إلهي كيف حدث هذا؟! وكيف لي أن أحدثك، أو أن أنظر في عينيك؟! لابدّ أنك سمعت صوت طائر الوقواق يملأ أجواء زنزانتك لحظتئذٍ. وودت الانتحار في المكان حالاً. أن أطوي حياتي، لكنني لم أفعل، إذلابد من مصارحتك يا راجي). وخرجت من ذلك البيت، دون ألتفت ورائي لأعرف أين كنت. فما عدتُ أهتمُّ بشيء سواك!! أخذت سيارة، ومضيت إلى غرفتنا الصغيرة، وهناك، غبت عن العمل والناس لاحساسي بأن العالم كله يعرف ما حدث!! ومرت الأيام بقسوتها البالغة!!
ولم يسأل عني لا في البيت ولا في العمل. (بالمناسبة، كذّبتُ على الأستاذ بهجت مديرنا، تعرفه، قلت له كنت مريضة، فهزّ رأسه وقلّب كفيه في الهواء ولم يقل شيئاً) وذهبت إليه. مرة أخرى تردد حرّاسه كثيراً بالسماح لي؛ لكن وبعد إلحاحي، وحالة الصخب والذعر التي أثرتها، وافقوا، فدخلت إليه. استقبلني كعادته بكل اللباقة، واللطف. كان مبتسماً فرحاً وكنت حزينة. لم أقل له شيئاً عن الذي حدث في بيته، لم أعاتبه، عفواً، لم أسبه، ولم أضربه بحذائي. سألته عنك. فقال: إنك بخير. ورجوته أن أراك. فقال: لكل شيء أوانه.. اصبري. وصبرت أربع سنوات أخرى، ولم أركَ خلالها إلا مرة واحدة من خلف الأسيجة الكثيرة.
بدوتَ لي شبحاً باهتاً كالحلم، لكن الطمأنينة شاعت في روحي حين حدثتك. لعلك تذكر لم أقل لك سوى (راجي)، ولم تقل لي سوى (بديعة)، وأبعدوني عنك وأبعدوك عني، ومع الأيام، وبعد انقطاع طويل رأيتك مرات عديدة، من بعيد أيضاً، ومن خلف الأسيجة لعلك لا تدري بأنني كنت أفقد شيئاً من روحي كلما فقدتَ أنت سياجاً من الأسيجة التي تفصلك عني. كنت أدفعُ الثمن بالانتظار الطويل المذل، والأسئلة المرّة، والرجاءات اللجوجة، صدقني كان كلُّ هذا من أجلك، للحظة التي ستأتي وأضمّك فيها إلى قلبي. كان همّي أن أراك حيّاً، أن أمسح وجهك براحة يدي بكل الرهافة التي تعرفها، وبعدئذ فليأتِ الطوفان. كدت أنسى الحياة والناس من أجلك. ذهبت في نشوة رؤيتك إلى أبعد الحدود. رؤية تأتي بعد ألف سنة من الغياب، ما أروعها!كنت أواجهك من بعيد، وأشتاق إليك وأنا طي صمتي. كنت تقول لي بأنك بريء. (وأنا أعرف هذا. صدقني، أعرف هذا، أنت أنظف من العين يا راجي؛ أتسمع..أنظف من العين!!) وأنهم لم يجدوا شيئاً يُدينك؛ لكنك متخوف من عثورهم على بعض الأوراق والملفات. وسألتني كم مرة فتشوا غرفتنا، وقلت لك ألف مرة. نقّبوا في كل مكان، ولم يجدوا شيئاً. وقلت لي: بديعة انتبهي، توجد كمية قليلة من الأوراق والكتابات- من أيام مراهقتي الطويلة، وأحلامي الكثيرة- في إحدى زوايا المطبخ مخبّأة تحت بقعة الجبصين، غطّيها بالدهان. ومازحتني بأن كمية من صحفات المجلات والجرائد القديمة التي كانت ممنوعة آنذاك.. مخبأة في الحمام فوق قطعة الخشب (البلاكية) التي تسقفه، إن احتجت إليها.. إمسحي بها أي شيء، ولم تدر يا راجي أنك كنت تبني بأقوالك هذه أسيجة جديدة بيني وبينك لكي تبقى في حقل الأحزان هذا!! طبعاً أنت لا تدري كيف. فبعدما حدثتني أن إشاعة قوية منتشرة عن قرب خروجك مع آخرين، رجوتني أن أسأل مأمور السجن عنها، فسألته!. فأكّد لي بأنك ستخرج فعلاً، وسألني أن نلتقي فرفضت مقابلته خارج حقله هذا، ورفضت استقباله في غرفتنا بعدما كان يتندر بالمكان وسكانه. قلت له: لن تلمسني إلا بعد أن تخرج روحي! ما حيرني أنني بدوت له كأنني المرأة الوحيدة التي تعنيه في العالم. (مات.. لكي يختلي بي). تودّد كثيراً، وترجّى، ولم أقبل. كنتَ معي، بعدما أيقنت بأن بهجة الحياة على مبعدة خطوة واحدة.
لكن المفاجأة كانت اثنتين. واحدة منه، والثانية مني، جئت إليه من أجل رؤيتك بعدما تأخّر موعد خروجك وطال. قلت له: رائحة راجي تكاد تخنقني. دعني أره أرجوك. ورفض.. انحنيت على حذائه وقبّلته. أفزعني منظر لمعان لعابي على مقدمة حذائه، وغصصت. قبّلته مرة ثانية.. لكي يسمح لي برؤيتك، ورفض أيضاً. عاودني كابوس السنوات الماضية التي لم أرك فيها. تمنيت أن أراك ولو مرة واحدة فقط. صارت غايات الدنيا كلّها غاية واحدة؛ أن أراك بقامتك العالية وأنت تذرع الشارع أيباً من العمل أو ذاهباً إليه. المهم أن أراك حيّاً! وإذا ما فقدتُ هذا الأمل سأضع رأسي على مخدتي وأنهي حياتي. طالبته كثيراً، ورجوته.. فرفض. قال لي: لديه شريط تسجيل قصير، وفيلم جميل.. قصير أيضاً. أسمعك الشريط ثم تشاهدين الفيلم، وبعدها تتصرفين (كنت أعتقد بأنه أعد لي مفاجأة، كأن أسمعك وأنت تجيب عن الأسئلة، أو وأنت تبكي وتصرخ، أو وأنت تتوسل وترجو، أو أن أراك في حالات ضعفك، وأنت تعالج جروحك وتبكي، أو وأنت توسّخ على ثيابك في حالات الألم العنيف! بل قلت ربما أعدّ لي مفاجأة سارة أن أراك، وأنت في وحدتك تأكل وتشرب، أو وأنت تقرأ الصحف والكتب أو تغسل ثيابك، أو وأنت تغني أو تشاهد التلفزيون، لكن المفاجأة كانت غير ذلك تماماً)!! لقد سمعتُ نفسي وأنا أرجوه أن يكثر لي من جرعة السعادة وبصوت ناعم، كأنني في غرفة النوم. وصرخت به. فأوقف شريط التسجيل، ثم أمرني أن أرى.. فشاهدت نفسي أيضاً، في بيته، وفوق سريره.. عارية لا ثوب يسترني ولا غلالة.. وجننت. هاجت الروح يا راجي. أحسست بأنني أفقدك؛ أفقد كلَّ شيء، أفقد حبي لك الذي عمّرناه معاً طوال الأيام الماضية. فوقفت. قلتُ له سآتي إليك غداً، بعد أن أكون قد فكرت جيداً. (بالمناسبة، لم أقل لك.. جاءتني أم شامان مرات عديدة وهي تبكي، بعد ما رأته يأتي إليَّ؛ إلى غرفتنا الصغيرة.. يقرع الباب طويلاً وينتظر، ثم يقرعه كثيراً وينتظر فلا أفتح له. وحين سألتني عنه، أخبرتها، فما كان لي ولها سوى أن نتقاسم البكاء لوقت ثم تواسيني.. ونفترق)!!
وجئت إليه في اليوم الثاني، ومعي المفاجأة. جئت بكل الأوراق والملفات، وصفحات الجرائد والمجلات التي خبّأتَها أنت، وسلمتُها إليه. جئت بكل ما يمكن أن يُدينك، وبما يبقيك في السجن.. كي لا تخرج يا راجي. فترى أوتسمع ما فعله مأمور سجنك الوسيم بي في غفلة مني ، كي لا تراني، وقد فضحني خجلي منك. كي يظل حبنا خالداً. كي لا ينهار!! وثق بأنني لن أمنحه شيئاً ولو أمّروه على الهواء. سأظل لك وحدك. أتفهم!!. وحدك!!.
ملحوظة:
كنتُ قبل قليل أودعك يا راجي، أعرفك ذكياً.. أما لاحظت؟!
بديعة
حسن حميد