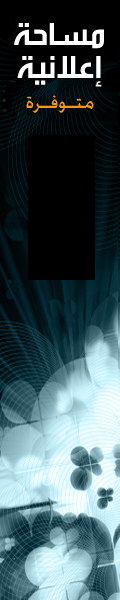شاعر فاق الشاعرية ، لازمه الحزن الشفيف لحلم جميل بالعودة للوطن ، واسترجاع الحق الضائع، لم تثنه الظروف القاتمة عن البوح بما في ضميره بنفس طويل وأمل ممدود ،يتبع أفقًا سريعًا أصيلًا يتواءم مع نبضاته الشاعرية العالية ، التي لامست الوجود بأشكاله المختلفة فجعلته نابضًا حيًا.
إنه شاعر الوطن الحي ، والكلمة الصادقة ، والهم الجمعي ، والإنسانية ، إبراهيم السعافين ، صاحب ديوان " أفق الخيول" ، الذي فاقت كلماته كل هم وجرح يُخَيّم على الواقع الحي ، فالتأمت الجراح بعقد كلماته ، ومات اليأس بدغدغة مشاعر الأمل والعزة لكل من يحظى بقراءة أي قصيدة من الديوان .
فحزن البرتقالة في مستهل الديوان ، هو حزن الفلسطيني على أشجاره التي اجتثت ، بما دعاه إلى الحيرة من قسوة الاحتلال الذي قطّع الأشجار، وأهلك الزرع .
ولم يَبْقَ لصاحب الوطن سوى الطيور المغردة رمز الحرية والكرامة ؛ ليسائلها عن الجريمة البشعة التي جناها العدو على الأرض والإنسان.
" وقفت أسائل الأطيار عن أشجار بستاني
لتنزف من جريح القلب أطياف من
الحسرة" (1).
إن حال الفلسطيني مجترحة بالغربة ، والأحزان ، والأسرار المكتومة ، وقد مثل إبراهيم السعافين هذه الحال خير تمثيل لما قال في ختام القصيدة نفسها :
"وتهمي من عيون البرتقال
مدامع الغربة
...
وتهدأ في عيون البرتقال
كوامن الأسرار
ويهمي الحزن والأمطار ..."(2).
حيث جمع بين الأضداد ، وتمثل الحزن وهو يهمي ثم يهدأ ، وشَخَّص الحزن الإنساني بعيون البرتقال ، الذي كان قد رآه في ظلال القصيدة مخضبًا :
" بلون دمائنا في القدس في يافا
وفي الرملة" (3) .
ولعل المقطع الأخير من القصيدة كثّف الرؤية الشعورية ، بجمعه بين الحزن وهو يهمي والأمطار الكفيلة بغسل جراح الفلسطيني ودمائه ، لما تنهمر على أرضه لتبث الحياة فيها من جديد ، وترجع حقه المسلوب بأمر إلهي ، إذ هو منزل الأمطار ، ومجري السحاب ، والقادر على كل شيء.
إن حزن الفلسطيني حزن وجودي، إذ خَلْفَ كل باب بيت فلسطيني يقبع الحزن والأسى والصمت و "الليل البهيم " ، و " مسارب الأحزان تجأر في المدى" ، ومع كل هذا الأسف فإن أنغام القصيدة تتوق للفرح ومجاوزة هذا الخمود للبيت الفلسطيني ، وإحياء روح معالمه المزدانة بظل الزيتون والخير. ويبقى الشوق يؤجج النفوس للعودة والحرية والانعتاق من قيود الاحتلال :
" لا تنطفئ يا ضوء بيتي
أشرق على الزيتون في رُحبِ
الحقولْ
فلقد غفا الشوق الخجولُ إليكَ
من زمن الأفول
فالنار في عمق الرماد تهزّ
أركان الجدار
وجدائل الزيتون سارحة
تغني للنهار" (4).
إن الفلسطيني يعشق الحياة منذ طفولته ، ولا يعرف إلا الحب لكل ما يحيطه من أقانيم الوجود والكون ، فهو خُلِقَ محبًا للطبيعة بما تحويه من زهر ، وعشب وحقول وشجر:
" كنت طفلًا يعشق الزهر
وأنغام المطر
ويحب الحقل والعشب
وأنفاس الشجر" (5).
ويبدو أن الشتات والضياع والفرقة هي المصير المقدّر لهذا الفلسطيني " العاشق الجوال" ، الذي عشق أرضه ووطنه ، فأنكر العدو منه هذا وحاول أن يبعده عما أحبه ، ويظل السؤال القائم :
" هل يؤوب العاشق الجوّال
أم ليس يؤوب" (6) .
لقد ذاق الفلسطيني من الغربة ، والوجع، والضياع ، مرارة لم يشعر بها أحد سواه ، وهذا ما يجعله يعيش في قلق وجودي دائم ، يبث في خاطره سؤال الهوية ، والغاية من وجوده ؟ متعجبًا من كثرة المآسي والمصائب وتكالب الأحزان عليه .
" ورحت أطوّف في كل صقع
وأنمو على حركات السنين
كبرت وفي خاطري مغزل
لينسج فيّ سؤال الوجود:
"فمن أين جئت ؟
وما غايتي ؟
وما لفني في ثياب الضجر؟!"( 7) .
لقد قدم الفلسطيني تضحيات كثيرة ، وعاش مغامرات قاسية ، حتى بات " ابن الغابات" ، الذي سحرته محبوبة متفردة مع أنه غازل الكثيرات من الإنس والجن ، ولكن هوى فلسطين له سحر خاص ، أعجز العرافين عن وصفه وصفته ، فهي الغواية الكبرى التي أغرت بمفاتنها الجميع ، وهي العشق المقدّر ، والأزلي في قلب كل فلسطيني ، ارتقى في حبه لها لأسمى غايات الهوى ، وامتزج فيها إلى حد الذوبان ، فخلد الرواي حكاية هذا العشق الجنوني الذي مزج بين الشيطانية"سر النار " والإنسانية " سر الطين" ،التي هي سر وجوده في الحياة ،فحبه وجودي منذ الأزل ، ويجمع جميع المتناقضات ، التي تمثلها ثنائية الشيطان والإنسان:
" هذي ليلى يا ابن الغابات
فها قد صدقت الرؤيا،
تمتزجان شهابين،
وتذوبان
...
قال الراوي :
هذا سر النار ، وسر الطين
من آفاق الأزل إلى آماد الأبد
الخالد" (8) .
ويبدو في الأبيات السابقة مزج عجيب ، يثير الغرابة بجماليته ، إذ يستحضر القارىء قصة ليلى وحبها المشهورة في الأدب العربي ، وقصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل " الفداء" ، والخلق الأولى في آن واحد .
و فلسطين في حالها تشبه " المهرة المستفزة" ، والفلسطيني مولع فيها بفطرته ، فكيف تجني عليه أيضًا بالاستفزاز ، ويبقى الهوى بينهما متأصلًا لا يحول ، أما الواقع فإنه يستفز نفس الفلسطيني المحب لأرضه بالحرمان ، فيتساءل نافيًا، أتوجد قوة دائمة أو ممكنة تحرم أرض الوطن من نسمات الحرية ، وفرح أبنائها " رقصات الخيول" بها وعليها وفيها ؟
" فأيتها المهرة المستفزّة ...كفّي!!
...وما حالة العشق حالًا
تحول
ولكنْ ...
فمن ذا الذي يحرم الأرض من رقصات الخيول! "(9) .
في الحب يخلد المرء وطنه ، والحرية هي الثمار التي ستجنى ولو بعد حين ، ويتجلى في الأبيات السابقة تناص خفي مضاد مع نص المتنبي :
"زودينا من حسن وجهك ما دام فحسن الوجوه حال تحول".
يعبر فيه عن ديمومة عشق الفلسطيني لأرضه ، وأنه لن يحول أو يتحول في يوم من الأيام عنها ، فبعده عنها ظاهري أملته ظروف الواقع المرير ، ومع هذا فإن الظلام لن يكسر شيئًا في النفس ، ويومًا ما سيرجع كل حبيب لما يحِب ولمن أحب .
والظلم الذي لاقاه الفلسطيني أكبر من أن يوصف ، فهو جرّب كل أشكال المعاناة وصورها ، من سلب وقهر وانتهاك للأرض والمال والولد ، والتشريد والشتات على يد الجبناء والجبابرة ، وقد استحضر الشاعر أسطورة شمشون الطاغية المتجبر ، ليعبر فيها عن اليهود المتجبرين على الفلسطينين ، فقال :
" ماذا بعدُ؟!
...
شمشون الجبّار
وحذاء النبلاء الأمريكان
داس عصافير الشجر الغافي
فارتحل الحب إلى منفاه السري
وتمطى الويل
وهاجرت الخيل " (10).
ويظل الأمل الموعود ملازمًا للطفل الفلسطيني ، مع كل المشاهد المهولة التي عاينها ، وكل الدمار الشاخص أمام ناظريه ، والقصف لأحلامه البريئة ، فيقف على ما خلفه العدو من دمار وقتل وأشلاء مترامية ليغني أغنيات الفجرالقادم دونما انقطاع ، فيسترق الحنّون السمع لشدة جمال هذه الأغنيات وحسنها :
" وقف الأطفال على الأطلال يغنّون
لعيون الفجر المسجون...
فزها الحنّون ..
يسترق السمع ، وخطوات الأطفال
في حقل الزعتر والزيتون:
تدق ، تدق ، تدق ، تدق" (11) .
ويبقى العربي في حالة من الخجل لما يستحضر الوطن الأسير ، وحال الضياع والشتات التي عاشها الفلسطيني ، فهي وصمة عار يحياها العربي وتسري في نفسه كسريان الدم في الوريد ، فيغني قائلًا :
" فوا خجلي حين يمطرني
الذلُّ
أسأل عنهم!!
...وأخجل منهم
كأنّي وَهُمْ...
لعنةُ في الوريد..." (12).
ويبقى العشق ، هو سلوة الفلسطيني أمام هذا التخلي الذي لاقاه من غيره ، والأحلام الهاربة من سجن الاحتلال والعدو هي ملاذه الوحيد الآمن :
" تدور الليالي
وقلبي على عتبات العصور
يلملم أحلامه الهاربة
ويرقص ، يرقص
لا يستريح
يسائل أحلامه الكاذبة " (13) .
ولا يجد له مشاركًا في حلمه السامي إلا " النخلة" التي امتدت في الفضاء الإلهي ، وساحت فيه ، فينادي :
" يا نخلة في فضاء الله سابحة/ ناشدتك الله أن تشجي لأشجاني" (14).
لكن ثمة من يحاول أن يفسد الأحلام ، ويتاجر في الحلم الفلسطيني ، وحقه في الوجود ، والبقاء على أرضه :
" لكن التنين الحارس ووحوش الغاب
باعوا أحلام النخل وأحلام الأطيار
وأحلام عذارى الماء ، وعاثوا أفّاقين
لا تحزن يا نخل الله
فهذا زمن الأفاقين" (15).
فيصرخ الفلسطيني متمنيًا توقف الزمن ، الذي مضى عمره فيه راحلًا ، دون أن يرى شمس الحرية، أو حلمًا يتحقق ، فقد تجمدت الأحلام ، ودمر العدو الصهيوني أبهى أزهار الوطن وأبنائه.
" توقف أيا زمن الراحلين
فإن الشموس محاصرة
بالبنادق
وإنّ رياح الصقيع تغيرُ على الحلم ، من كل فج ،
وتقتل أبهى الزنابق
توقف أيا زمن الراحلين
فأخشى عليك الزمان المنافق..!!" (16).
ومع هذه القسوة والمرارة ، يحمل الفلسطيني بكلماته وعذاباته وارتحالاته حقه في الوجود ، ويرسم صورة وهم الوجود للآخر المدمر والسارق والهادم والمجرم والوحشي :
" تعذبني كلماتي
تدخل في كل جروحي
...
نعرف ، نعرف أنهم الغربان
وأنّا أطيار أبابيل
...
إنا نعرف أنكم زبد البحر
غثاء سيول الأرض
صبوا كل رصاصكم
...
أقسم بالتين والزيتون
وطور سنين :
" هذا البلد الراحل في الدَّم
لي وحدي ...
ولغيري ما كان" (17).
التناص الديني في هذه الأبيات ظاهر ، وغايته تصوير حال الفلسطيني المؤمن في حقه بالوجود والحياة ،مهما حاول العدو الذي لا يعرف إلا لغة الرصاص طمس معالم هذا الوجود.
فإيمانه بحقه في العودة لا تشوبه شائبة ، وقد أقسم عليه قسمًا مقدسًا لن تدنسه خطوات العدو على أرضه ؛ لأنها وهم مختلق لن يدوم .
هوامش المقالة :
(1) إبراهيم السعافين ، أفق الخيول ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط1 ، 2005م ،ص5.
(2) نفسه ، ص7.
(3) نفسه ، ص6.
(4) نفسه ، ص10_11.
(5) نفسه ، ص12.
(6) نفسه ، ص13.
(7) نفسه ، ص17.
(8) نفسه ، ص23_24.
(9) نفسه ، ص26_27.
(10) نفسه ، ص30.
(11) نفسه ، ص35.
(12) نفسه ، ص36_37.
(13) نفسه ، ص38.
(14) نفسه ، ص41.
(15) نفسه ، ص43.
(16) نفسه ، ص47.
(17) نفسه ، ص49_ 53.
* كاتبة وأكاديمية من الأردن