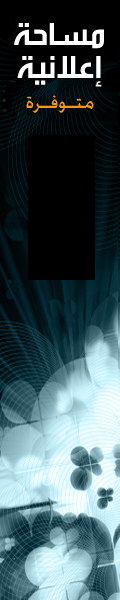ماذا كنت أريد أن أقول؟ نعم، كنت أريد أن أحكي قصة ذلك الزبون الذي يشتري
مني كل مساء ثلاثة أقراص من العجوة، إنه زبون من نوع خاص، هذا النوع
الذي يحس ببعض الغبطة- أمام أصحابه على الأقل- لأن له صديقاً عجوزاً يبيع
العجوة، أنت تعرف أن ربحي بهذا البيع ليس كبيراً ولكنه، والحمد لله، كاف، فأنا
أشتري كل ثلاثة أقراص من العجوة بفرنكين اثنين، وأبيع الواحد بفرنك، ليس هذه
فحسب، بل إن مجموعة كثيرة من الزبائن تدفع فرنكاً دون أن تأخذ قرصًا، وهذه
هي المجموعة المفصلة عندي، نعم، كنت أريد أن أحكي قصة ذلك الزبون ولكن
ما الذي جعلني أنسى؟ آه! ذلك الشرطي ذو الوجه المجروح، إن كثيراً من رجال
الشرطة لهم نفوس طيبة، ولكن هذا الشرطي لم يعجبني أبداً! هل رأيته كيف
تصرف؟ هل أنا المذنب؟ لقد كنت واقفاً هناك، على المنعطف عندما اقترب مني
وقال وهو يهز طبق العجوة "يجب أن تذهب من هنا!" لقد كان شرطياً جديداً، هذا
مؤكد، إذ أن بعض الشرطة الطيبين المسؤولين عن هذا الشارع، كانوا يسمحون
لي أن أقف هناك.. عندما قال الشرطي ذلك، حاولت أن اشرح له بعض الأمور،
لكنه رفع طبق العجوة إلى رأسي وقال: "يجب أن تحمد الله أنني لم أضعه على
رأسك مقلوباً" ثم دفعني دفعة شديدة، كأنني يهودي، ولكنني لست يهودياً، وأنت
تعرف أن هذه إهانة كبيرة إذ أين كان هذا الابن الحلال يوم كنت أحارب اليهود
في الطيرة وفي حيفا؟ أين كان؟ آه! حذار أن تتصور أنني ناقم على هذا
الشرطي..
الحمد لله على أي حال.الحمد لله أنني لم أكن خائناً ولا جبانًا في يوم من الأيام.
ولو كنت كذلك إذن لما كنت سامحت هذا الشرطي.. والذنب في هذا ليس ذنبه..
إنه ذنب الذي أضاع فلسطين وحتم علينا حياة الكفاف هذه، حتم علينا أن نعيش
وكأننا خرجنا من فلسطين كي نبحث عن عمل ما فقط..
على كل حال أنا أعرف ما الذي أضاع فلسطين.. كلام الجرائد لا ينفع يا بني، فهم
–أولئك الذين يكتبون في الجرائد يجلسون في مقاعد مريحة وفي غرف واسعة فيها
صور وفيها مدفأة، ثم يكتبون عن فلسطين، وعن حرب فلسطين، وهم لم يسمعوا
طلقة واحدة في حياتهم كلها، ولو سمعوا، إذن، لهربوا إلى حيث لا أدري، يا بني،
فلسطين ضاعت لسبب بسيط جداً، كانوا يريدون منا –نحن الجنود- أن نتصرف
على طريقة واحدة، أن ننهض إذا قالوا انهض وأن ننام إذا قالوا نم وان نتحمس
ساعة يريدون منا أن نتحمس، وأن نهرب ساعة يريدوننا إن نهرب.. وهكذا إلى
أن وقعت المأساة، وهم أنفسهم لا يعرفون متى وقعت! إنهم لم يعرفوا قط كيف
يقودون جنودهم.. كانوا يحسبون أن هؤلاء الجنود ضرب طريف من الأسلحة..
تحتاج إلى حشو.. صاروا يحشونها بالأوامر المتناقضة، كان الواحد منا يحارب
اليهود فقط لأنهم يريدون أن يحاربوا اليهود!..
لقد كان هناك أيضاً بعض القادة المخلصين.. ولكن ماذا يستطيع الواحد منهم أن
يفعل لوحده؟ ماذا يستطيع أن يفعل ملاك، سقط فجأة إلى جهنم، وعلقت جناحاه في
براثن الشياطين؟ لقد تيسر لي أن أدخل معركتين مع إبراهيم أبو ديه، رحمه الله لم
يكن يحارب إلا وهو واقف على قدميه كأنه يلقي خطاباً، وكنا كلنا نندفع إلى الأمام
كأننا ذاهبون إلى عرس.. رحمه الله.. أنا أعرف شيئاً كثيراً عن حياته، لقد بدأ
صغيرا مع عبد القادر الحسيني يأخذ الرسائل عبر الجبال إلى الرفاق، ثم كبر
إبراهيم، وحمل البارودة، ونزل إلى المعركة، كان ذكياً جداً.. وفي 1948 خاض
مع رجاله معركة في "ميكور حاييم" وخرج منها بست عشرة رصاصة في ظهره
كانت سبب شلله، ثم أمضى أربع سنوات بعدها يتعذب.. أنت تستطيع أن تتصور
كيف يكون شعور رجل مشلول أمضى حياته واقفاً على قدميه.. لقد كان ينظر،
فقط، ثم يبتسم، ويعود إلى التفكير بخمس وعشرين ليرة يحتاجها يومياً ثم حقن
المورفين تهدئ من عذابه بعض الشيء.. كان يتعذب. إلى أن فكرت بعض الدول
العربية في أن تساعده وبعد مشاورات قررت له راتباً شهرياً لمدى الحياة، وسافر
مندوب عن هذه الدول إلى بيروت ليزف البشرى.. وعندما دخل الغرفة، كان
إبراهيم أبو ديه يحتضر، وكان ثلاثة رجال يقفون إلى جانب سريره يبكونه..
وطلب إبراهيم منهم بصوت خفيض أن ينشدوا له نشيد موطني.. ووقف الرجال
الثلاثة ينشدون له النشيد، وهم يبكون، بينما كان هو يموت، رحمه الله..
لقد تعذب طويلاً.. وبينما هو يموت دخلت الغرفة امرأة كبيرة في السن.. وقدمت
له باقة صغيرة من الزهر الأحمر..
ما اسمه؟.. "الشقيق".. نعم " الشقيق"، يسمونه هناك في القرى " الحنون" وقالت له
وهي توشك أن تبكي..
- هذا الحنون"... من هناك.
وأمسك إبراهيم الزهر.. وضمه بعنف إلى صدره، ثم ابتسم وهو يقول..
- أيها الجرح..
ومات وهو يشد على الزهر الذي دفن معه.. أرأيت كيف يموت الأبطال دون أن
يسمع بهم أحد؟ أرأيت؟
لم يكن هذا في القدس فقط.. بل في كل مكان... خذ هذا المثال.. لقد كان في
"هادار" حيفا مطحنة كبيرة تقتل الناس في شوارع الكرمل دون حساب، لم يكن في
حيفا كلها لغم كبير يكفي لنسف هذه المطحنة.. ثم تيسر، بما لا أعرف كيف، أن
يذهب قائد حامية حيفا، يومذاك حمد الحنيطي إلى "سوريا" وأن يرجع بلغم كبير،
وعندما دخل من رأس الناقورة، استطاعت امرأة يهودية أن تعرف هذا السر،
فأبلغت بواسطة اللاسلكي مستعمرة تقع بين عكا وحيفا.. اسمها؟ لا أذكر.. المهم..
مر حمد من عكا في المساء مع رفاقه ومن بينهم "سرور برهم" هل سمعت عنه؟
حسناً، لقد وصلوا قرب المستعمرة قبل أن يهبط الظلام وهناك فاجأته قوة يهودية
تريد أن تستولي على اللغم، وطلبت منه أن يستسلم، ولكنه رفض.. ودافع دفاعًا
مجيدًا مع رفاقه القلائل حتى تساقطوا من حوله واحداً إثر واحد.. هل يسلم اللغم
وينقذ حياته؟ طبعاً لا.. لقد وقف حمد ورفع يديه، وهندما اقترب اليهود ليمسكوه،
أطلق رصاصة واحدة على اللغم الكبير، لقد قال الناس يومها أنهم سمعوا انفجار
اللغم من عكا.. وتطايرت أشلاء اليهود، وتمزع الشهيد إلى درجة أنهم لم
يستطيعوا أن يجدوا أي شيء منه كي يدفنون..
ماذا كنت أريد أن أقول لك؟.. آه.. إن المسؤولين لم يحافظوا على أبطالهم.. ولم
يكونوا على معرفة بأي أصول للمعارك.. لقد استشهد القائد مع رفاقه، أنا لا أريد
أن أناقشك في أنه تصرف على شكل معقول أو متهور، ولكن أريد أن أسأل.. ماذا
حدث لأهالي الشهداء؟ والقيادة في حيفا كيف تصرفت حتى تملأ المكان الذي خلفه
الشهداء؟ ألم تدب الفوضى في حيفا إلى درجة مؤلمة؟
ماذا أريد أن أقول؟ آه، عن المسؤولين وعنا.. خذ ما هناك كان يشتغل العمال
العرب واليهود، جنباً إلى جنب، وكنت أنا أشتغل في ذلك المصنع، وجرى حادث
صغير نسيت معظم تفاصيله، لقد ألقى يهودي قنبلة على حارس عربي كان يقف
على باب المصنع، فقتله، وكان حزننا شديداً عندما سمعنا عن موت الحارس
ورفاقه، فأغلقنا الباب الكبير للمصنع ثم استعملنا في قتل الصهاينة جميع الوسائل،
لقد تقابلنا يومذاك وجهاً لوجه وكلانا مجرد من سلاحه، ولم يكن أي محل يتسع
لسوى الرجولة فقط، واستطعنا أن نتغلب عليهم، لم يكن عندنا في الداخل، سلاح
من أي نوع، فاستعمل بعضنا "التراكتور" واستعمل أكثرنا الرفش والفأس ذا
الرأسين الطويلين، وحدثت المعركة. لم نبق على عدو واحد، كان معظمنا جديداً
على هذا النوع من القتال، ولكن الجميع قاتلوا كأنهم رجل واحد، رامين إلى
الشيطان بمستقبل وظائفهم، غير آبهين البتة إلى توسلات اليهود الذين كانوا يقولون
أننا عمال أكلنا العيش والملح سوية.. ثم ماذا حدث بعد ذلك، بعد أن قتلنا عشرات
اليهود؟ وبعد أن تركنا أعمالنا في "الريفاينري" وأخذنا نتجول في الشوارع
كالشحادين كما أتجول الآن، هل تعتقد أنهم أعطونا أسلحة وقالوا لنا: حاربوا
معنا.. وموتوا معنا؟ لقد أهملنا المسؤولون إلى درجة أنني سمعت أنهم قالوا أننا
جزارون ولسنا محاربين وهم حتماً لا يحتاجون إلينا فلذلك علينا أن نذهب إلى
حيث نشاء كي نحارب كيف نشاء.. وضد من نشاء! جزارون! هكذا قالوا.. وأي
نوع من المحاربين يريدون؟ محاربون يلبسون المعاطف البيضاء ويردون على
الجرائم اليهودية بابتسامات عذاب؟ أم يريدوننا أن نحارب بمحاضر جلسات جامعة
الدول العربية؟.
اسمع ماذا جرى لهذا المحارب المهذب.. لقد كان سائقاً لسيارة عمومية، وشاهد
امرأة يهودية تعدو هاربة أمام مجموعة من الأطفال كانوا يرجمونها بالحجارة..
كانت الحوادث في بدء توترها، فما كان منه إلا أن نهر الأطفال، وأمسك المرأة
من يدها، وقادها إلى حيث أوقف سيارته، وذهب بها إلى أهلها في تل أبيب، هل
تعرف ماذا حدث هناك؟ لقد سرقوا سيارته، وقتلوه. مزقوه ورموا جثته مقابل
جامع الشيخ حسن.. فكيف يريدوننا أن نحارب أناسًا من ذلك النوع؟ بالورود؟
هذا هو الذي أضاع فلسطين، يا بني، هل تفهم من هذا أنني أريد أن ترسل رسالة
شكر إلى كل جندي يصيد عدوه؟ كلا.. كلا.. معاذ الله.. لكنني كنت أعني أن
عليهم أن يتفقوا على شيء ما.. أن يقرروا كيف يتوجب عليهم أن يتصرفوا.. أن
يحترموا شعور المحارب الذي يفقد رفاقه في كل معركة.. على أي حال أنا لا
أريد أن أحدثك كثيراً عن المعارك، لقد كنت كل عمري أضحك على أولئك
العجائز الذين لم يجدون غير ذكريات قتالهم في السفر برلك يسمعوننا إياها، ولكن
الذي أريد أن أقوله، أنني حاربت، أكثر مما يستطيع الشخص الواحد أن يفعل،
ولكن الخطأ لم يكن مني أنا، كان من فوق، من هؤلاء الذين يقرأون ويكتبون
ويرسمون خطوطاً ملتوية ينظرون إليها باهتمام.. أما أنا.. فماذا أستطيع أن أفعل
غير أن أحمل بارودتي وأن أهجم، وأن أنظر إلى حيث يشير رئيسي ثم أركض
في ذلك الاتجاه وسلاحي في يدي؟
المهم أن علينا أن لا ننسى ما حدث عندما نلتقي مرة أخرى.. وأن علينا أن
نحارب اليهود كما يفعل محررو الجرائد أولئك في غرفهم عندما يجدون كمية
كبيرة من الذباب!
كم أنا ثرثار
كنت أريد أن أحكي لك عن ذلك الزبون الذي يشتري مني ثلاثة أقراص من
العجوة دفعة واحدة كل مساء.. ولكم الحديث جرني، والذنب في هذا، هو ذنب ذلك
الشرطي الذي طردني من مكاني المختار كأنه يطرد لصاً..
لو أنني حكيت لذلك الشرطي قصتي، وقلت له من أنا إذن لضحك ضحكًا
متواصلاً، ولقلب الطبق على رأسي كما كان ينوي أن يفعل. لذلك فأنا لا أطلب منه
أن يحترمني.. فهذا شيء مضحك.. لكنني يوماً ما، سآتي من فلسطين ماشياً على
قدمي، كما أتيت في المرة الأولى، وسأبحث عن الشرطي هذا ما استطعت، ثم
سأدعوه لأن يقضي شهرًا كاملاً في طيرة حيفا على حسابي.. له الخيار في أن
يتنقل فيها كما يشاء، ويقف حيث يشاء..
دمشق - 1957