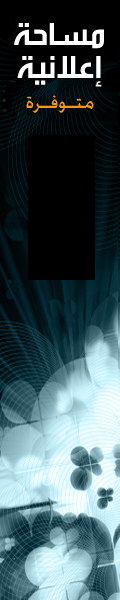عبد الرحمن منيف.. الروائي الذي خلق ذاكرة ثانية
فيصل درّاج
كيف يتجاوز المثقف المغترب اغترابه، وهل تستطيع الكتابة أن تصاول سلطة تبذر الكوابيس؟ سؤالان أجاب عنهما التاريخ أكثر من مرة، منذ أن راهن عبد الله بن المقفع بحياته وهو يوجّه رسالة بريئة إلى سلطان لا يعرف البراءة، وصولاً إلى طه حسين الذي آمن بقوة الثقافة. على الرغم من صلابة الجواب، الذي يعرفه المثقفون وينكرونه، فقد آمن عبد الرحمن منيف، كغيره، بأن في الكتابة المتمردة ما ينصر الأحياء والأموات العادلين، وبأن في كتابته ما يعزّز مواقع معركة قديمة. ولعل وضوح الرؤية، منذ البداية، هو الذي جعل منيف يواجه، مدة ثلاثين عاما، <<التاريخ السلطوي>>، الذي يخادع مَنْ لا سلطة لهم، ب<<الذاكرة الروائية>>، الحالمة أبداً بسلطة محتملة تعترف بالحقيقة. لم تكن كتابته، وهو الراحل من مكان إلى مكان، إلا سيرة ذات مغتربة، أرادت لذاتها أن تكون سيرة أمة حاصرها الاغتراب. وعن هذا المشروع، الذي أخذ أشكالاً كثيرة، صدر مشروع كتابي مثابر مايز، بإيمانية لا تعرف المساومة، بين الذاكرة الوطنية المشغولة ببناء تفاصيلها، والذكريات التي تخفق في فضاء الأحياء زمناً ويلحق بها البَدَد. وما رواية منيف إلا تلك الذاكرة المليئة بالأصوات، التي اعتقد صاحبها أن في صفحاتها المديدة ما يعيد الحق إلى نصابه، في مستقبل عصي على التحديد.
إنه سؤال المضطهَدين، الذين يعيشون اضطهاداً يقاتلونه، منتهين إلى كتابة ذاتية تعبّر عن تجربة معيشة، تواجه كتابة متسلّطة، تمنع الكلام عن ضحايا المتسلّطين وتتحدث باسمهم. وهو ما فعله إدوارد سعيد في كتابه <<الاستشراق>>، الذي مزج بين <<المعرفة الموضوعية>> وتصفية الحساب مع أكاديميين طويلي العهد، يمزجون <<العلم الراقي>> بالعنصرية الكريهة. كان سؤال منيف، الذي دخل عالم السياسة مبكرا، مختلفاً عن سؤال سعيد، فلا موضع للاستشراق ولشرق مخترع لا وجود له، لأن المكان كله احتشد بمعادلات قومية تعيد إلى <<أمة العرب>> مجدها التليد، وتطلق الأصل العربي حراً في سهوب المستقبل. وصل منيف إلى عوالم الرواية قادماً من عوالم الخيبة السياسية، فما آمن به <<المناضل السياسي>>، ودعا الآخرين إلى الإيمان به، انفتح على خراب لا ضفاف له. ومع أن في رواية <<حين تركنا الجسر>>، وهي تحيل على هزيمة حزيران عام 1967، ما يعبّر عن أزمة جيل عربي، فإن في استبطان الهزيمة إلى تخومها القصوى ما يستدعي سيرة ذاتية، تتهم مراجع آثمة وتبحث عن الخلاص. كان منيف، وهو يضع على لسان <<صيّاده>> المخذول حواراً ذاتياً شاسعاً، يحاور ذاته الإيديولوجية، التي كانت، منتقلاً من عالم الإيمان المتفائل إلى عوالم الاحتمال، ومن غرف السياسة المخادعة إلى عالم الرواية الطليق. بيد أنه، كعادته دائما، لم يشأ أن يجعل من روايته فضاء ذات منغلقة على حسبانها، بل شاء أن يضع تجربته الفردية الجماعية في ذاكرة مكتوبة، تتطيرّ من كل سلطة مستبدة مهما كانت غاياتها. وهذا الفردي، الذي لا ينفصل عن مجموع بريء يماثله، هو الذي يجعل <<الصياد>> المخذول يدور فوق أرض موحلة صقيعية، قبل أن يعود إلى الشوارع ويذوب في جموع البشر. جاءت الذاكرة من بؤس التجربة، وجاءت الذاكرة المكتوبة، أي الرواية، رداً على سلطات مهزومة، تكتب ما شاءت وتطرد الحقيقة. كان في سعي منيف ما يرّد، حالما، على مكتبات الظلام، التي تحوّل الحق إلى ذكريات، وتحتفظ بما قتل الحق في أقبية <<الأرشيف>>، الذي يختزل الكتابة إلى عنصر أمني بين عناصر أخرى.
الروائي والمؤرخ
الأرشيف السلطوي أم الكتابة الروائية؟ هذا هو سؤال منيف الطويل، الذي جابه به سلطات مختلفة، تصيّر أجناس الكتابة إلى أسانيد في أرشيف سلطوي، يجانس بين المعارف جميعا. منهج مستبد قديم، ينكر المتعدد ويحتفي بالأحادي، إذ الشاعر السلطوي مؤرخ، والمؤرخ اقتصادي كاذب، وعالم الاجتماع يكمل ما جاء به الطرفان. وإذا كان نجيب محفوظ قد جعل من السلطة المصرية المتواترة نقيضاً للقول الروائي، منذ أن أعلنت <<أولاد حارتنا>> عن يأسه الأخير، فقد جعل منيف من السلطات العربية سلطة عاتية واحدة، تلتهم شعوبها وتتحدّث عن الكرم العربي. لا غرابة، إذاً، أن يعهد منيف إلى ذاته بمشروع كتابي مرهق، يكون الروائي فيه مؤرخاً ومحللاً سياسياً وناقداً ثقافياً وعالم اجتماع في آن، محاولاً أن يستدرك، روائيا، ما لا تسمح به الرقابة الرسمية، لائذاً ب<<المكر الروائي>>، الذي تحدث عنه محفوظ غير مرة. وما روايته <<شرق المتوسط>> إلا صورة عن هذا المكر البريء، الذي يراد به <<خير الأمة>>، كما يقول أهل الاختصاص، الذي سوّغ به محمد المويلحي <<أكاذيبه البيضاء>>، في <<حديث عيسى بن هشام>>، في مستهل القرن الماضي. واعتماداً على المكر المتاح، حلل منيف في <<شرق المتوسط>> استراتيجية الحاكم المستبد، الذي يضع داخله كل شيء، محولاً ما خارجه إلى فراغ لا شكل له. فبعد اللسان المسجون الذي عليه أن يكتفي بحاسة الذوق، كما جاء في قصص زكريا تامر، يأتي السجن الصغير، الذي يعطي السجين ولادة قاتلة، يتلوه السجن الكبير، الذي تضطرب فيه قامات متساوية، متناظرة في القول والمشية والرغبات.
ليست الذاكرة الروائية، كما أرادها منيف، إلا ذاكرة حقبة من الزمن، يكون فيها الحاكم هو <<الحر الوحيد>> في مجتمع من العبيد. ومن أجل توطيد هذه الذاكرة، التي تأتي من الواقع وتذهب إلى لامكان، عيّن الروائي الراحل السجن موضوعاً ثابتاً في رواياته، توقف أمامه في <<الأشجار واغتيال مرزوق>>، وأفرد له <<شرق المتوسط>>، وعاد إليه من جديد في <<الهنا والآن، شرق المتوسط مرة أخرى>>، قبل أن يعطيه مكاناً واسعاً في <<مدن الملح>>. ولعل هذا الهاجس، الذي لا ينفصل عن تداعٍ عربي متجدد، هو الذي جعل رواية منيف مزيجاً من الشفهي والمكتوب، إن صح القول، أو موقعاً للشفهي المكتوب، حيث الروائي يعير المضطهدين قلمه ويستعير منهم حكايات حزينة المآل. وما <<اللغة الوسطى>>، التي تحدّث عنها منيف وبنى بها رواية ذاكرة، إلا آية على حوار الشفهي والمكتوب، الذي ينقض <<الذاكرة الرسمية>>، وينقض معها لغة سلطوية متكلسة، تحتفي بالمرتبة وأصحاب المراتب، وتنظر إلى العامة و<<لغة العوام>> باحتقار يساكنه التكفير.
وكما تكون السلطات التي تمحو الهزائم بالبلاغة تكون حداثتها. في <<النهايات>>، وهي من أجمل ما كتب، يوحّد منيف بين ذاكرة المقهورين وذاكرة المكان، مستدعياً السلطة تحت ضوء جديد. يأتي المكان الطبيعي رحباً نظيفاً مصقولاً مؤثثاً بالطيور والغزلان وبإنسان مسالم، هو وجه من وجوه الطبيعة وأحد أبنائها. والعلاقة بين هذه العناصر هي الصيد المحسوب، الذي تحكمه الغريزة، فلا يهلك الصياد جوعاً ولا تباد الغزلان. على خلاف الصيد الذي يصون توازن الطبيعة منذ زمن قديم، تأتي السلطة بصيد جديد له شكل المجزرة، مزودة بالبنادق الرشاشة والسيارات الحديثة ولاعقلانية متمددة تدمر عقلانية الطبيعة وتوازنها القديم. فبعد أن أجهزت السلطة، التي تسمح بتحديث أجهزة القمع وتمنعه خارجها، على المجتمع والمدينة، التفتت إلى الطبيعة البريئة، جاعلة منها حقلاً للرعب والمطاردة وامتداداً للسجن الكبير. ولعل تفتيت أوصال الطبيعة بلا حساب، هو الذي دفع منيف إلى تفريد المكان، كما لو كان شخصية غنائية واسعة لا ينقصها العقل والإرادة، تشكو من السلطة وتثور عليها وتردم سياراتها المصفحة بالرمال. تأخذ السلطة في <<النهايات>> مجاز اللعنة الميتافيريقية، أو دلالات الشر المكتمل، ذلك أنها تدخل إلى مكان يضجّ بالحياة، وتخرج منه وقد تحوّل إلى مقبرة، فالعصافير تاهت عن أعشاشها وأضلاع الغزلان تدكّها السيارات وصياد القرية الأليف يفارق الحياة. واجه منيف قبح السلطة بجمال الطبيعة وانتهى إلى مرثاة حزينة، تتحدث عن طيبة الحيوان والشر السلطوي. لا شيء إلا شظايا جمال قديم، إلا ذلك الخلاء البارد المفتوح على التهلكة والبوار وعدل يتجدّد تأجيله إلى الأبد. شيء يُذكّر، بشكل مختلف، بذلك الخلاء الترابي المقفر، الذي انتهى إليه العادلون في <<أولاد حارتنا>>، إذ <<الفتوة>> هو <<الفتوة>>، وإن تغيرّت الأسماء، وإذ <<الملك هو الملك>>، كما قال سعد الله ونوس ذات مرة.
في <<مدن الملح>>، التي أرادها كاتبها ذاكرة عن مصائب الأمة الكبرى، شاء الروائي أن يفصح عن أمور كثيرة : على المستضعفين أن يحررّوا تاريخهم الذاتي من كتابات أملتها السلطات التي انتصرت عليهم، ذلك أن مَنْ يمتلك الكتابة الأولى يمتلك المكان، وأن تحرير المكان من براثن مغتصبيه يستلزم كتابة مغايرة تقول بتاريخ آخر. جمع منيف جدل الكتابة والتحرّر في خمسة أجزاء، صاغها صوت مفرد يحسن الكتابة احتشد بأصوات جماعية، تروي الحكايات ولا تحسن الكتابة. أفضت هذه العلاقة إلى <<متواليات حكائية>>، بلغة محمد دكروب، تحرّر الحاضر من انغلاقه وتفتحه على مستقبل مليء بالاحتمالات. غير أن الروائي، الذي أعار صوته إلى غيره، قاسم هذا الغير الحكايات ولم يقاسمهم الرؤية، حين نفي أسطورة الأصل الذهبي، معلناً أن حقيقة الماضي قائمة في الحاضر المهزوم، وأن حقيقة الزمنين لا مكان لها، لأنها رهن بذاكرة جديدة تحسب ولا تخطئ الحسبان. ف<<ثقافة الأدعية>>، بلغة طه حسين، لا تصد آلة أوروبية تنفذ إلى <<الأرض السابعة>>، فما يصدّها عقل يميز بين العلم والبلاغة. مع ذلك فإن الروائي، الذي آمن بقوة الذاكرة وضرورة صنعها، لا يلبث أن يشتق الأمل من تناقضات السلطة المغلقة، التي كلما زاد عنفها زاد خوفها موزّعة العدل، وفي لحظة تناقض طريفة، على الحاكمين والمحكومين معا. فإذا كانت الرعية لا توجد إلا في حرّاسها، الذين يقيسون المسافة بين القامة والظل، فإن السلطة لا توجد إلا بالأجهزة التي تؤمن لها سلامة موقتة. هكذا يدور الطرفان في فضاء مغلق من الخوف والانتظار منتهيا، إن طال عهده، إلى مقبرة أو ما هو شبيه بالمقبرة. تحدّث منيف في روايته الطويلة، وبشكل إيقاعي، عن بشر يسهرون وينتظرون ويتوقعون، من دون أن يعطي قولاً صريحا، أو يقع في تبشير لا معنى له. والسؤال الكبير هو التالي: ما فائدة الذاكرة إن كان البشر، الذين خلقت الذاكرة من أجلهم، ينتظرون ولا يفعلون شيئاً آخر؟ يعثر الروائي على الجواب في اليوتوبيا، ويضعها داخل البشر لا خارجهم وينتظر المستقبل، إنْ لم يضع اليوتوبيا داخل الكتابة ويقنع بالاحتمال. وهذه اليوتوبيا التي تتوارثها أجيال متواترة، تنتظر الانتصار، هو الذي يجعل <<مدن الملح>>، في مستواها العميق، رواية عن الموت والكتابة، تؤمن بأن الحاضر هو الزمن الحقيقي الوحيد، الذي يتلوه زمن آخر يعثر بدوره على قلم جديد، يتحدث عن الموت والكتابة بشكل جديد.
جدل الكتابة والتحرر
يقول العارفون: <<إن التاريخ هو ما تحكم حقبة أنه جدير بأن يحتفظ به من حقبة أخرى>>. فلا حقبة تنتسب إلى التاريخ إلا قياساً بحقبة أخرى اخترقها التاريخ، في شكل نصر مدوٍ أو هزيمة كاسحة. فبعد <<مدن الملح>>، التي اقتفت آثار ناصح أوروبي، أراد ترويض الصحراء بقليل من ماء البحر، ارتد منيف، في <<أرض السواد>>، إلى ناصح إنكليزي آخر، جاء إلى أرض العراق مع مطلع العقد الثاني من القرن الثامن عشر. لم يكن الناصح الأول، الذي ذكر يحيى حقي اسمه في مذكراته <<كناسة الدكان>>، إلا العقل التقني الأوروبي المتوسع، الذي يعيد هندسة المكان المغتصب، ويبني له من الأجهزة ما يحفظ سلامته، ويبدّد سلامة أصحاب المكان الأصليين. أما الناصح الثاني، ويدعى <<ريتش>>، فلا يختلف في وظيفته عن الأول، وإن كان أكثر غطرسة. يبدأ الحوار بالوعيد وينهيه بأصوات المدافع. واعتماداً على معنى التاريخ، الذي تحتفظ فيه حقبة بما جاء في حقبة نظيرة أخرى، رأى منيف إلى ذاكرة مغلوبة، تستعيد دروس محمد علي باشا، ورأى إلى ذاكرة منتصرة، هزمت محمد علي باشا وداود العراق الطموح وما جاء بعدهما. وبعد أن واجه الروائي ذاكرة السلطة بذاكرة الذين لا يحسنون الكتابة، جابه ذاكرة الغرب بذاكرة شرقية، لم ترَ من الغرب إلا الاحتلال والنهب. صاغ منيف، في روايته، ما دعاه مهدي عامل، في زمن غير هذا، بالعلاقة الكولونيالية، إذ على السلطة المحلية أن تجدد مصالحها، وهي تجدّد مصالح المستعمر الأجنبي التي لا تنتهي. وهذه المصالح، التي تفرض لاشرعية السلطة مبتدأً، هي في أساس السجن الكبير، الذي يغتال معنى الطبيعة بعد أن دمر دلالة المدينة. أراد الروائي أن يستدرك صمت المؤرخ، راضياً كان أو مغلوبا، فذهب إلى الوثائق التاريخية، وصاغها من وجهة نظر المحرومين، الذين حرموا حق الكلام، وحرموا حق تمثيل أنفسهم في الكتابة وما هو خارج الكتابة.
رد منيف على <<الذكريات>>، التي تتساقط في منتصف الطريق، ب<<ذاكرة>> حسنة التأثيث تقع في مجلدات كثيرة. كان مؤمنا، في مشروعه، بخلق ذاكرة لا فجوات فيها، تجسر المسافة بين الغفلة واليقظة، ومؤمناً أكثر بقوة الكتابة، التي تصد عن المغلوب النسيان، وتضع بين يديه ذاكرة نموذجية سهلة التناول، يعود إليها حين يشاء. يظل السؤال، كما كان دائما، يقول: هل من ضمان يقنع المغلوب، الذي يهدّده النسيان، بالعودة إلى ذاكرة مكتوبة دورها هزيمة النسيان؟ لا جواب، ذلك أن الكتابة تأتي من إرادة أخلاقية وتذهب إلى حيث شاءت لها الأزمنة. فلو كان في الكتابة العادلة ما ينصرها لانتصر العادلون منذ زمن طويل.
رجل ناحل يتكئ على قلم يسجل به، سنوات طويلة، حكايات الذين اندفنوا مع رغباتهم العادلة، مؤمنا، بلا حسبان، بأن نصرة الحق تقوم في التنديد بنقيضه لا أكثر. رجل ناحل صلب الإرادة بسيط الكلام، انتسب ذات مرة إلى جموع من الحالمين ومكر به الطريق، فانصرف إلى رثاء جيله والدفاع عن حق الإنسان العربي في أحلام جديدة. كان هذا عبد الرحمن منيف، الذي رأى إلى الحياة بصفاء كبير، زاهداً بالمفيد ومكتفياً بالصحيح، إلى حدود التقشف والبطولة.